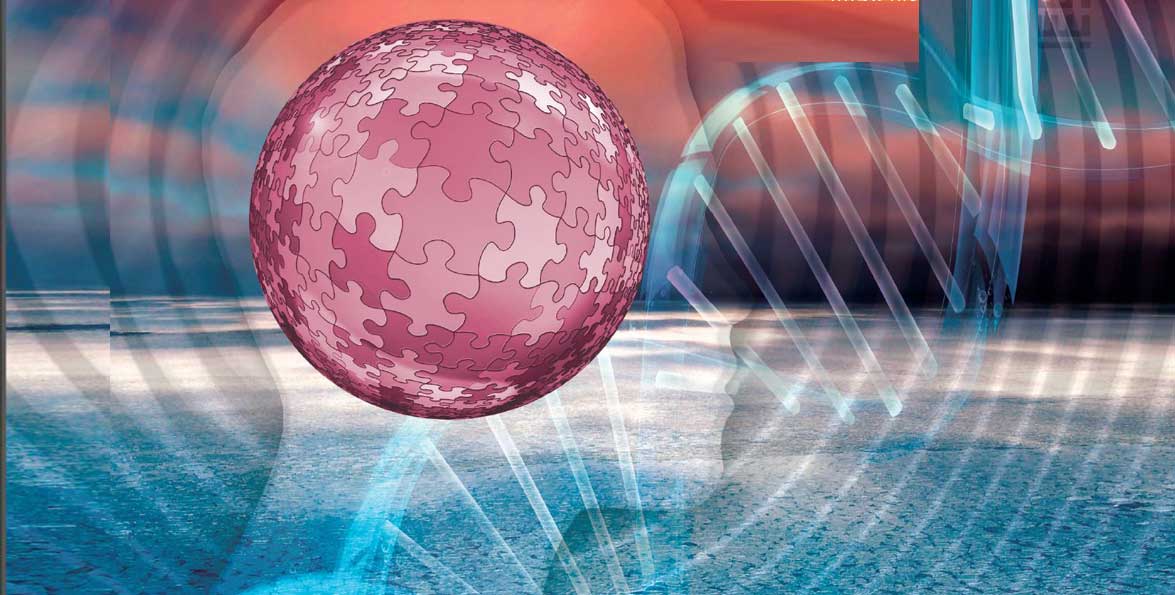4- آفاق القراءة والتلاوة للآيات
حين نتحدث عن تجديد العلوم الإسلامية، وجب استحضار مستويات علمية تعد بمثابة الرافعات المنهاجية للعملية التجديدية، وهي كالآتي:
المستوى الأول: القراءة
إن أول ما أشرق من أنوار هذا الوحي الخاتم على دنيا الإنسان هو قوله سبحانه: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)(العلق:1-5)، ومنذ هذا الإشراق الأول يتبين لنا أن ثمة أمرًا بقراءتين:
القراءة الأولى: قراءة في الخلق: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ)، ولا شك أن هذه القراءة في الخلق لها أبجدها ولها آلياتها ولها خطواتها ولها مؤشرات تقويمها.
القراءة الثانية: هي القراءة في الكتاب المسطور: (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ). إن فعل القراءة في عالم الإنسان وفي دنياه أصبح -بحمد الله- ممكنًا بإقدار الله عز وجل لهذا الإنسان على هذه القراءة؛ وتجلّي هذا الإقدار في الجانب المنظور كان من خلال الأسماء وتعليمها: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا)(البقرة:31)(1).
أما في الجانب الذي هو جانب الكتاب المسطور فنجد الكلمات، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ)(البقرة:37). هناك إذن، الأسماء في الكتاب المنظور، وهناك الكلمات في الكتاب المسطور، وهناك -كذلك- المواءمة بين الإنسان وبين الكتابين، وهي مواءمة كانت ممكنة بسبب الدمغة الأولى والفطرة الأولى: (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)(الروم:30).
وتقوم هذه المواءمة الممكّنة من القراءتين في الجانب المنظور “الكوني”، وفي الجانب المسطور “جانب الوحي”، على مجموعة من الأسس أبرزها البنائية. ففي الجانب المنظور “الجانب الكوني”، نجد أن هذا الكون بناء عضوي: (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)(الذاريات:47)، (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا)(النازعات:27-28).
وهذا البناء له مقصدية هي التسخير: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ)(لقمان:20)، وفي مواطن من كتاب الله يبرز أن هذا الكون وحيُه هو أن يتسخّر لك أيها الإنسان، ومنها قوله تعالى: (وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا)(فصلت:12)، وقوله سبحانه: (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا)(الزلزلة:4-5)، وحيًا جديدًا، فحين يقول الإنسان: ما لها؟ ما لها لا تتسخر؟ يكون الجواب: إن ذاك الوحي القديم الذي هو وحي بالتسخر، قد نُسخ كما قال الإمام القرطبي في جامعه: “بوحي جديد هو وحي بعدم التسخر؛ لأن زمن الحساب قد أزف”، وهو قوله تعالى: (وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ)(الانشقاق:3-5). فهذا الكون إذن مسخَّر، ويمكّن من هذا التسخير كون الإنسان قادرًا على تفهّمه من خلال المقوِّمات التي زوَّده الله عز وجل بها، وفي مقدّمتها المواءمة ثم قدرة معرفة الأسماء.
أما في الجانب المسطور “الوحي”، فنجد أنه هو أيضًا بناء؛ فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن المجيد فيقول: (وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً)(الفرقان:32)؛ والشيء الرَّتل هو الحسن البناء والنَّضد. والقرآن المجيد من خلال هذا البناء، كأنه جملة واحدة كما نصّ عليه أبو بكر بن العربي رحمه الله حين قال: “ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرّض له إلا عالم واحد.. ثم فتح اللٰه سبحانه وتعالى لنا فيه، فلما لم نجد له حمَلَة، ورأينا الخلق بأوصافِ البطَلَة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله، ورَدَدناه إليه”. وللإمام الشاطبي كلام أيضًا بهذا المعنى؛ أي أنّ “القرآن كالخبر الواحد وكالجملة الواحدة”، وابن حزم الأندلسي أيضًا له في إحكامه كلام يفيد هذا المعنى، والبرهان البقاعي، والبدر الزركشي وغير هؤلاء.. كلهم تكلّموا عن كون القرآن المجيد بناء عضويًّا، وأنه لا يفهم إلا بردّ بعضه على بعض.
وهذه البنائية هي التي مكّنت الإنسان من أن يقوم بالقراءة من خلال تلقي الكلمات، وهذا أبرز تجليات المواءمة بينه وبين كتاب الختم. وقد ذمّ الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عِضِين؛ أي الذين يفرِّقونه ويعضّونه، وذلك في قوله تعالى: (كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)(الحجر:90-91).
وإذا كانت القراءة في الجانب الكوني تتم بالتفكّر: (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ)(آل عمران:191)، فإنها في الجانب المسطور “الوحي” تتم بالتدبر: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)(محمد:24).
التسخير والتيسير ومفهوم القراءة في القرآن الكريم
من الأمور التي تتجلى من خلالها جمالية التعبير القرآني، التقابل بين “سخّر ويسّر”؛ فهناك التيسير: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) في أربعة مواضع من سورة القمر، وفي سورة مريم؛ (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ)، إلى غير ذلك من مواضع ورود التيسير في القرآن الكريم. وهناك التسخير الوارد في مثل قوله تعالى: (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ)(الأعراف:54)، (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ)(النحل:12)، (اللٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ)(الجاثية:12)، (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ)(الجاثية:13)، (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ)(الأعراف:54).
إن القراءة في الكون المسخَّر هي التي أعطتنا علوم التسخير، أي إن حوار الإنسان مع الكون من خلال هذه المواءمة التي له معه من خلال إقدار الله إياه على الدخول إلى مساربه بالأسماء، وتفكيك مجملاته هذا الحوار، هو الذي أعطى علوم التسخير التي تجعلنا قادرين على الحركة وعلى الفعل؛ إذ الكون هو مرجع الحركة ومرجع الفاعلية.
في الجانب الآخر نجد أن القراءة في الوحي الميسَّر هي التي أعطتنا علوم التيسير، فالحوار مع الوحي هو الذي مكّننا من القدرة على تبيّن الوجهة والقبلة المقصودة بالفعل والحركة، وحوار الإنسان المستدام مع الوحي من خلال بنائيته ومن خلال المواءمة التي له معه، وكذا من خلال القدرة على التفهّم بسبب الكلمات التي أوتيها وتلقّاها عبر الرسل الكرام -عليهم جميعًا أزكى السلام- هو ما مكّن من تنمية علوم التيسير. قال عليٌّ كرم الله وجهه: “ذلكم القرآن فاستنطقوه”، وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “ثوّروا القرآن”؛ أي حرِّكوه لكي يخرج مكامنه.
فالقرآن المجيد، في موازاة مع الكون الذي هو مرجع للحركة والقدرة والفاعلية، يصبح مرجعًا للقيم، ومرجعًا للوجهة ولحضور القبلة التي سوف ترشّد هذه الحركة. وجليّ أن القدرة على الحركة بدون قيم وبدون وجهة وبدون قبلة، قد تجعل من هذه الحركة فاتكة بالإنسان وبالأرض -الكوكب الذي يعيش عليه الإنسان- وبمحيط الإنسان.
وهو ما حذّر منه رب العزة في سورة الأعراف في سبع آيات مفصلاتٍ فيها بيان، أن العلاقة الوطيدة بين القراءتين هي سبب الحياة والنماء، كما فيها أن الانفصال بينهما سبب الفساد والهلاك، قال سبحانه: (وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ)(الأعراف:52-58).
إن العناية بإزاء القراءة في الكون مرجع الحركة والفعل، بالقراءة في الوحي لاستبانة القبلة، ولاستمداد الوجهة منه في محافظة دائمةٍ على الوصل، والجمع بين هاتين القراءتين هو ما يجعل الحركة والفاعلية راشدتين بانيتين: (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)(البقرة:256).
المستوى الثاني: التلاوة من خلال التجسير بين الوحي إلى الواقع
فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تلا الآيات في سياقه الذي هو المدينة المنورة، ورسم المنهج الذي به تكون القراءة، وتكون التلاوة، في استحضار للتمايزات المكانية والزمانية والذهنية التي لها تأثيرٌ وجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وقد سجل عليه الصلاة والسلام حالة الحكمة؛ أي وضع الشيء في موضعه.
إذ قراءاته -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأها باعتباره حالة السواء؛ فهو الإنسان الذي يشكل الوحدة القياسية، أي الحالة الأكمل الممكن تصورها في بني آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الإنسان الكامل الممكن الذي تبلورت فيه كل الفضائل، وكل المزايا، ومن هذه المزايا -والتي تُبين صلاحية حالة السواء، وتخرجها من الأحدية إلى المحمدية- كونه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)(التوبة:129-130)، وهو ما تؤكده أيضًا الآية الكريمة: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران:159). فالخروج من الأحدية إلى المحمدية، من لدن الإنسان الكامل الذي يشكل الوحدة القياسية -عليه الصلاة والسلام- هو الذي يجعل هذا التنزيل وهذه التلاوة، تكون بحسب مقتضيات الرحمة، وبحسب مقتضيات الرأفة سيرًا بسير الضعيف من أمته عليه الصلاة والسلام(2)، ورفعًا برفع الحرج عن ذوي الحاجة منها.
إن القراءة من حيث هي أداء لفظي للآيات والنص القرآني، هي تطبيق لأصل المعنى اللغوي للتلاوة وهو الاتباع والتتابع، ففي قراءة النص اتباع الألفاظ بعضها ببعض، هذا في إطاره الشكلي، أما في السياق العملي فهي الاتباع حقيقة وهو العمل بمقتضى النص ومعناه، وقد عبر عن هذا المعنى بالخصوص “حق التلاوة”، ذلك أن نتيجة التلاوة الحقة وصف الإيمان.
ونلحظ في معظم الآيات التي ورد فيها لفظ التلاوة باشتقاقاته المختلفة، أن السياق يدل على احتمال المعنيين وهو الأداء اللفظي وإتباعه بالعمل. وإذا أدركنا هذين البعدين للتلاوة، نستنتج أن وعي المعنى ركن هام من أركان التلاوة، هذا إذا قصرنا القراءة على الأداء اللفظي، أما إذا لاحظنا القراءة باعتبارها منهجًا، فإنَّها تتضمن الوعي بالمعنى، فتكون التلاوة مرحلة أعمق من القراءة إذ هي ترجمة للقراءة في السلوك والتطبيق.
وعليه فلا ترادف بين القراءة والتلاوة إنما ارتقاء في درجات التعامل مع النص. وفي معنى التتابع تأكيد لضرورة إدراك الروابط بين أجزاء النص واكتشاف المعنى، وبالتالي تحقيق معنى النص؛ فالتلاوة لا تكون إلا لنص، ومن ثم ترجمة معناه باتباعه. في اختيار هذا اللفظ للتعبير عن التعامل مع النص ملحظ مهم وهو أن القرآن إنما أنزل ليتبع، واتباعه يقتضي قراءته قراءة منهجية تكتشف نظامه بعد قراءة ألفاظه، ومن ثم متابعة هذه القراءة وترجمته إلى سلوك وتطبيق التلاوة.
المستوى الثالث: الترتيل
هو المستوى الذي سماه الله عز وجل ترتيلاً. والترتيل هو النضد، وهو الصفّ، وهو التنسيق في كل المستويات. والفم الرّتِل، هو الفم الذي قد انتضدت أسنانه(3). والترتيل لا ينحصر فقط في المستوى الصوتي، بل ينتقل إلى المستوى المفاهيمي، وإلى المستوى المرجعي النسقي، ثم إلى المستوى التنزيلي، ثم إلى المستوى التقويمي.. هذه المستويات يُسلم بعضها إلى بعض، فإذا لم ترتل صوتًا لن تستبين ما هو الترتيل لفظًا.. والترتيل لفظًا له مناهجه من دراسات مصطلحية ومفاهيمية وغيرها، دراسة للكلمة في بيئتها، وفي سياقها مع استحضار لضمائمها، ومشتقاتها، والتصنيف، وغير ذلك من الأمور التي تعطيك في النهاية فهمًا أقرب إلى الصواب للمصطلح القرآني، وهذا بدوره روض أنف، لم تطأه الأقدام الكافية وقد وجب.
(*) الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.
الهوامش
(1) ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس حين قال: “علَّمه حتى القصعة والقُصيعة”، والعلماء -وعلى رأسهم بهذا الصدد أبو الفتح ابن جني- على أنَّ المقصود بـ(وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا) هو إقداره على تسمية الأشياء، وهذا الإقدار هو الذي يمكّن الإنسان من تفصيل وتفكيك المجملات؛ بحيث يستطيع أن يأتي إلى مجمل ويفكِّكه، وكلُّ جزء ينتج عنده وينجم من هذا التفكيك يكون قادرًا على إعطائه اسمًا، فيضبطه في مكانه من خلال هذا الاسم، وهكذا يستمرّ في التفكيك، ويكون بعد ذلك من خلال هذه الصور والمعالم الأسمائية قادرًا على التركيب، أي إنها قراءة في اتجاهين: تفكيكًا وتركيبًا، قراءة قد أصبحت ممكنةً بسبب هذه القدرة على التسمية.
(2) إن عدم استبانة الوحدة القياسية أضحى يسبب مشكلاً مزمنًا وخطِرًا للعالمين، والذين طفقوا يبحثون عن الأبطال، ويتساءلون من هو البطل الذي يتبعونه، فتتعدد الدروب. وإذا بالإنسان يصبح في أمر مريج، لا يعرف من يتَّبع، وبمن يقتدي، ولا بمن يتأسّى.
(3) الصحاح 4/1704، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 3/35، “لسان العرب” (11/265)، تاج العروس 14/262، أساس البلاغة 220.