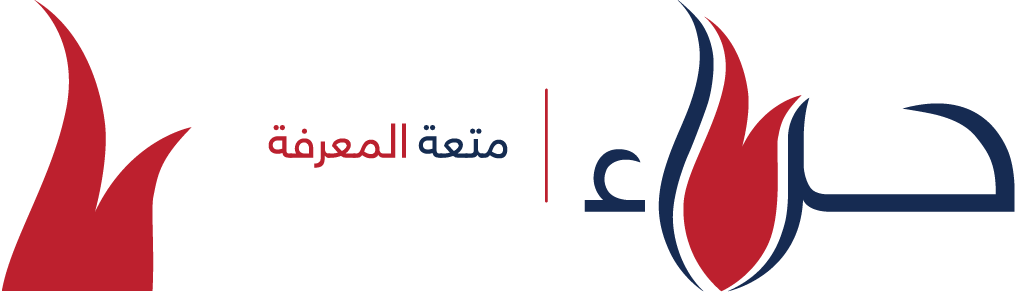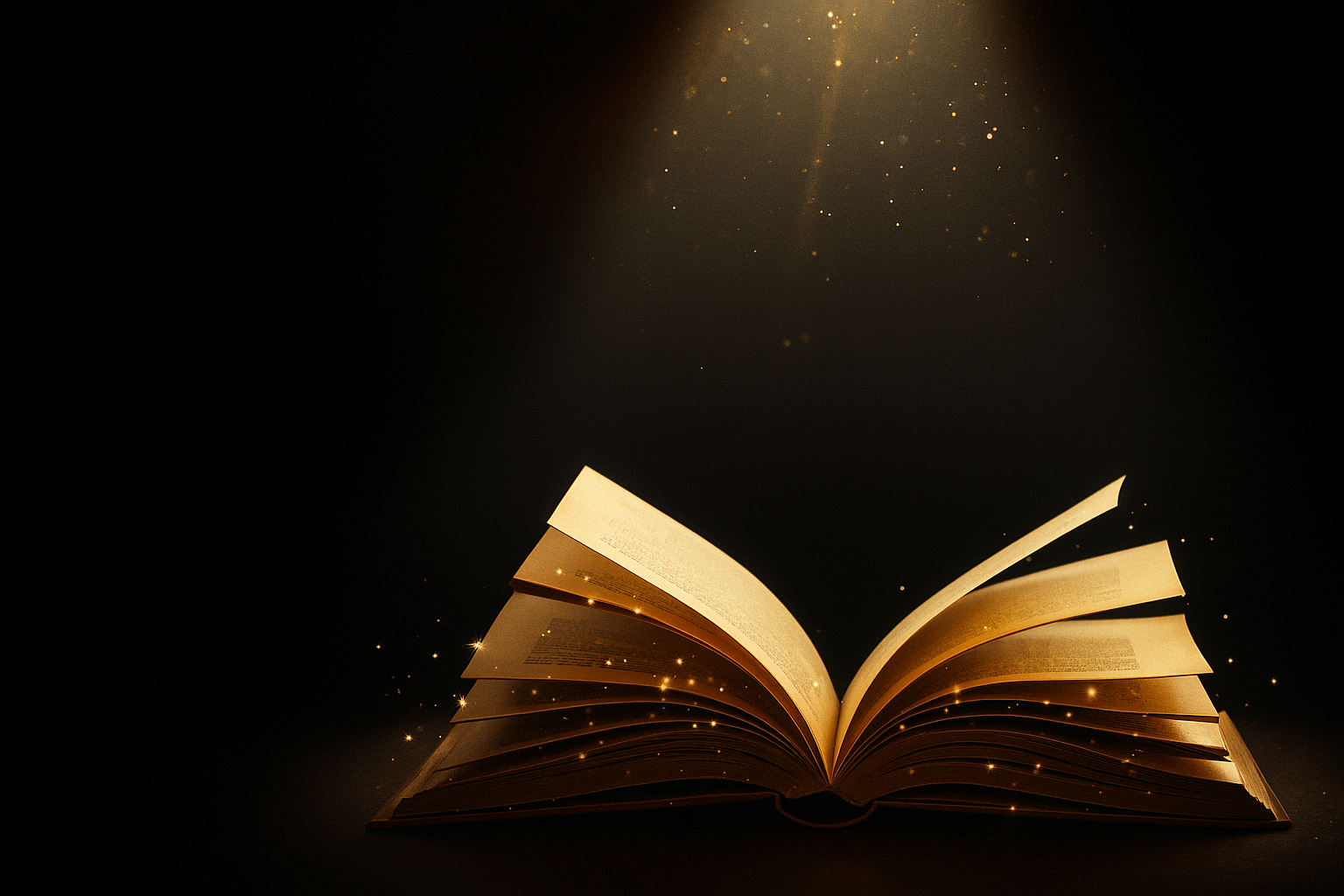إن الخلاف الأصولي حول مسألة اجتهاد النبي ﷺ لم يكن مجرد جدل نظري أو فقهي، بل انبنى على اعتبارات أخلاقية عميقة تتعلق بمقام النبوة، وقداسة الرسالة، ووظيفة النبي التربوية والتشريعية. ويمكن إبراز أهم هذه التعليلات كما يلي:
1- الخوف من الانتقاص من مقام النبوة:
ينطلق موقف المانعين من أساس أصولي وأخلاقي متلازم؛ فالنبي ﷺ موصوف بالعصمة في أقواله وأفعاله، والاعتقاد بأنه قد يجتهد ويصيب أو يخطئ يثير لديهم قلقًا معرفيًّا وأخلاقيًّا في آنٍ واحد. ويعكس هذا الخوف حرصًا أخلاقيًّا على ما يلي:
أ. حماية القداسة الروحية للرسالة:
إن الاعتراف باجتهاد النبي ﷺ في مسائل غير منصوص عليها يمكن أن يُفسَّر خطأً على أنه نقصان في مقام النبوة، ومن هنا يُعَدّ التمسك بعدم نسبة الخطأ إلى النبي ﷺ واجبًا أخلاقيًّا يهدف إلى صون هيبته وحماية الإيمان والرسالة من أي لبس قد يؤدي إلى تشويش لدى الأمة.
ب. صيانة الثقة الجماعية في التعاليم النبوية:
فالمجتمعات الإسلامية تستمد تشريعاتها وسلوكها من السنة النبوية، وأي تصور يضع احتمال الخطأ على اجتهاد النبي ﷺ يمكن أن يُضعف الثقة في تعليماته، مما يجعل حماية مقامه ضرورة أخلاقية للحفاظ على وحدة الأمة واستقرار نظامها الأخلاقي.
ج. تأكيد التفرد الأخلاقي والروحي للنبي ﷺ:
اجتهاد البشر بطبيعته معرضٌ للخطأ، أما اجتهاد النبي ﷺ فيقترن بالوحي والتوجيه الإلهي، والمانعون يرون أن إدخال فكرة الخطأ على اجتهاده يُخلّ بمقامه المتميز، ويهدد المثال الأخلاقي الذي يقدمه النبي ﷺ للأمة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى وضع حدود واضحة بين ما هو وحي وما هو اجتهاد بشري، حفاظًا على قداسة الرسالة.
د. تدريب الأمة على التمييز بين الحق والظن:
إن الخوف الأخلاقي من إسقاط الخطأ على النبي ﷺ لا يقتصر على الحفاظ على مقامه الشخصي، بل يمتد إلى تربية الأمة على حسن التقدير الأخلاقي للمعلم الأعلى، بحيث لا يُساء فهم الاجتهاد ولا يُخلّ بمبدأ التمسك بالحق.
إن هذا التعليل يُظهر أن الخلاف الأصولي حول اجتهاد النبي ﷺ يتجاوز مجرد نزاع فقهي، ليصبح مسألة أخلاقية مركزة على صيانة مقام النبوة وقداسة الرسالة، وضمان التوازن بين توجيه الأمة واستنباط الأحكام الشرعية دون المساس بالهيبة الروحية أو الثقة الجماعية في السنة النبوية.
2- الإحاطة بالكمال النبوي:
رأى المانعون أن تقسيم أقوال النبي ﷺ إلى ما هو وحي وما هو اجتهاد قد يوحي بقدرة البشر على الإحاطة بكمال مقامه، وهو تصور غير ممكن إلا لله وحده. ومن هذا المنطلق، اعتبروا هذا التصنيف نوعًا من سوء الأدب مع النبي ﷺ، إذ يضع حدودًا عقلية على شخصيته التي خصها الله بالكمال الإلهي والروحي.
ويظهر البعد الأخلاقي لهذا الموقف في النقاط التالية:
1- توقير النبي ﷺ وتعظيم مقامه:
إن التمسك بعدم تصنيف أقواله وفعله يحافظ على هيبته، ويعكس احترامًا عميقًا لشخصه ومكانته كخاتم الأنبياء، بحيث لا يُفهم أن اجتهاده بشريٌّ أو محدود.
2- حماية القداسة الروحية للرسالة:
إن تقسيم أقوال النبي ﷺ قد يؤدي إلى تصورٍ خاطئ بأن اجتهاده يخضع للخطأ أو لنقص معرفي، وهذا ما يسعى الموقف الأخلاقي إلى تفاديه حفاظًا على نقاء الرسالة.
3- التأكيد على أن الاجتهاد النبوي مقيد بالوحي والحكمة:
حتى إذا أُقرّ اجتهاده ﷺ، فهو مختلفٌ جوهريًّا عن الاجتهاد البشري؛ إذ يستند إلى علم شامل ووحي إلهي، ما يحفظ التوازن بين القيادة العملية للنبي ﷺ والقداسة الإلهية لشخصه.
يمكن القول إن هذا التعليل الأخلاقي يوضح أن المانعين يسعون إلى صيانة مقام النبي ﷺ وتعظيم رسالته، مع التمييز بين حدود المعرفة البشرية والكمال المطلق الذي خصه الله للنبي ﷺ، وهو موقف يربط بين الأخلاق وحماية العقيدة والتقاليد التربوية للأمة.
نسبة الخطأ إلى النبي ﷺ:
يُعد الاجتهاد بطبيعته عرضة للخطأ والصواب، وهذا ما أثار قلق المانعين بشأن اجتهاد النبي ﷺ؛ إذ رأوا أن إقرار أي اجتهاد قد يُحتمل فيه الخطأ، حتى في مسائل جزئية، يمثل انتهاكًا لمقام النبوة من الناحية الأخلاقية، ويُضعف قداسة الرسالة. فالتعليل الأخلاقي هنا يركز على حماية النبي ﷺ من أي تصور يربط مقامه بالخطأ البشري، والحفاظ على الثقة الجماعية في سنته وتعاليمه.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر المجيزون أن احتمال الخطأ في اجتهاد النبي ﷺ لا يُقرّ، بل يُصحح بالوحي، مما يضمن عدم المساس بعصمته ويؤكد تميّزه عن غيره من البشر. وهذا يعكس بعدًا أخلاقيًّا مهمًذا يتمثل في الموازنة بين حرية الاجتهاد واستمرارية القداسة الروحية للرسالة؛ فالنبي ﷺ مجتهد في الفروع العملية لما لم يرد فيه نص، ولكن كل اجتهاد يصيبه أو يُخطئ فيه يخضع لتوجيه رباني يصون مقامه، ما يرسخ قدوة أخلاقية وعلمية للأمة في كيفية الاجتهاد مع احترام النص والحقائق الشرعية.
تعكس هذه المسألة عمق البعد الأخلاقي في النقاش الأصولي، حيث يتداخل الاعتبار العقدي مع الأخلاقي والتربوي؛ فالحفاظ على مقام النبوة وعصمته يتكامل مع التأكيد على أهمية الاجتهاد في استنباط الأحكام العملية بما يربط الأمة بالحق والعدل والمصلحة العامة.
إمكانية مخالفة اجتهاده ﷺ:
أثار الاعتراف باجتهاد النبي ﷺ لدى المانعين مخاوف عميقة تتعلق بوحدة الأمة واحترام قدوة النبي ﷺ؛ فهم يرون أن فتح باب الاجتهاد أمام الناس في مقابل اجتهاد النبي ﷺ قد يؤدي إلى نوع من الخلاف غير المنضبط أو التنافر الاجتماعي والديني، ويُفسَّر على أنه انتقاص من القداسة والعصمة التي خصَّ الله بها نبيَّه ﷺ. ومن هذا المنظور، يحمل موقف المانعين بعدًا أخلاقيًّا واضحًا، يتمثل في: حماية السلوكيات الشرعية الجماعية، ومنع التشويش على الالتزام بالشرع، وصيانة القدوة النبوية من أي استغلال خاطئ للاجتهاد البشري.
أما المجيزون، فيؤكدون أن اجتهاد النبي ﷺ ليس مجرد فعل شخصي، بل نموذج تربوي وأخلاقي يوضح للأمة كيفية استنباط الأحكام في مسائل لم يرد فيها نصٌّ صريح. ومن هذا المنظور، فإن الخلاف معه -لو حدث- يكون في جزئيات العملية الشرعية، وليس في أصل العقيدة أو الرسالة، ويُصحَّح بالوحي. وهذا يبرز بعدًا أخلاقيًّا آخر يتمثل في تربية الأمة على الاجتهاد المسؤول، وربط العمل العقلي بالمعايير الشرعية والروحانية، بما يحفظ توازن الحرية العملية مع احترام القدوة النبوية.
ويضيف هذا الموقف المجيز قيمة تربوية واجتماعية مهمة، إذ يُعلِّم المجتمع أن الاجتهاد ضمن ضوابط الوحي لا يؤدي إلى الفوضى أو الانحراف عن المسار الشرعي، بل يُسهم في تمكين الأمة من مواجهة الوقائع المستجدة بوعي ومسؤولية، وتفادي الركون إلى الجمود في الفهم والتطبيق. كما يرسخ مفهوم الاجتهاد الأخلاقي، الذي يجمع بين الصدق والأمانة والنزاهة في العمل الشرعي، وبين التمسك بالرسالة الإلهية وتوقير مقام النبي ﷺ.
إن الخلاف الأصولي حول إمكانية مخالفة اجتهاد النبي ﷺ يوضح الترابط بين البعد الأخلاقي والاجتهادي والاجتماعي؛ إذ يسعى المانعون إلى حماية مقام النبي ﷺ ووحدة الأمة، بينما يُبرز المجيزون أهمية القدوة التربوية والحرية المسؤولة في الاجتهاد. وكلا الموقفين يعكس فهمًا متجذرًا في الأخلاق والغاية الشرعية، ويؤكد أن الاجتهاد النبوي لا يُفسد العقيدة ولا يقوّض القداسة، بل يُثري الفهم ويؤسس لممارسة اجتهادية رشيدة للأمة.
البعد التربوي والقدوة العملية لاجتهاد النبي ﷺ:
يرى المجيزون أن اجتهاد النبي ﷺ ليس مجرد اجتهاد بشري عادي، بل هو اجتهاد مسدَّد بالوحي، يحمل أبعادًا تربوية وأخلاقية عميقة، فهو يعلِّم الأمة كيف تتعامل مع النصوص الشرعية، ويُظهر لهم كيفية الموازنة بين الأدلة المختلفة وتحقيق مصالح الناس بما ينسجم مع مقاصد الشريعة.
ويكتسب هذا الاجتهاد بُعدًا أخلاقيًّا واضحًا، إذ يعكس الحرص على توجيه الأمة نحو المسؤولية والتمكين في البحث عن الحق، مع مراعاة القيم العليا للعدل والنزاهة والأمانة في استنباط الأحكام. ومن ثم، فإن إقرار الاجتهاد النبوي يربط بين التوجيه الروحي والتربية العملية، ويؤسس لأسلوب حياة متوازن يربط بين الالتزام بالشرع والقدرة على الاجتهاد المنضبط وفق المعايير الأخلاقية والشرعية.
ويُجسِّد هذا البعد التربوي أن اجتهاد النبي ﷺ يشكِّل نموذجًا قدويًّا للأمة، ويؤكد أن التفاعل العقلاني مع النصوص تحت إشراف الوحي لا يهدد القداسة النبوية، بل يعزز وعي الأمة ومسؤوليتها الأخلاقية في ممارسة الاجتهاد.
خاتمة:
يتضح من دراسة الخلاف الأصولي حول اجتهاد النبي ﷺ أن هذا الجدل لم يكن مجرد نقاش فقهي أو نظري، بل يمتد إلى أعماق أخلاقية وتربوية. فالمجيزون يرون في اجتهاد النبي ﷺ وسيلة للتربية العملية للأمة، وللتأسي بسلوكه في استنباط الأحكام الشرعية، وإبراز الأبعاد الأخلاقية في ممارسة الاجتهاد. بينما يخشى المانعون أن يفضي القول باجتهاده إلى المساس بقدسية النبوة وعصمتها، وإسقاط مقام النبي ﷺ على أي خطأ بشري محتمل.
وهكذا، يعكس هذا الخلاف توازنًا بين قيمتين أخلاقيتين متقابلتين: التوقير المطلق لمقام النبوة من جهة، والاستفادة التربوية والتعليمية من الاجتهاد النبوي لبناء وعي شرعي واعٍ لدى الأمة من جهة أخرى. ويؤكد في النهاية أن الاجتهاد النبوي، بما يحمله من أبعاد أخلاقية وتربوية، يظل نموذجًا فريدًا يجمع بين الحفاظ على القداسة الروحية للنبي ﷺ، وتمكين الأمة من ممارسة الاجتهاد المسؤول تحت ضوابط الشرع ومقاصده العليا.