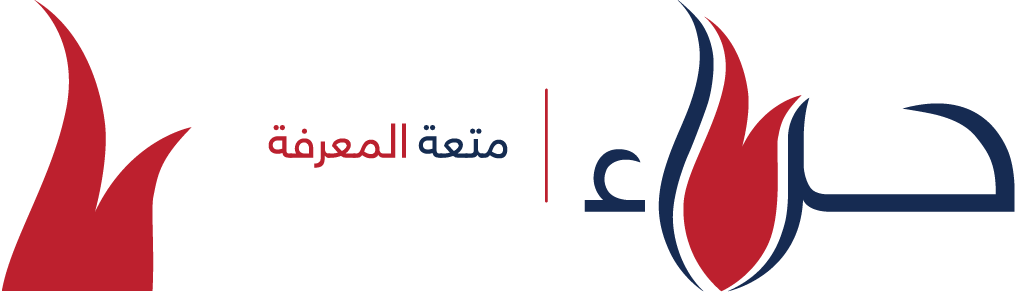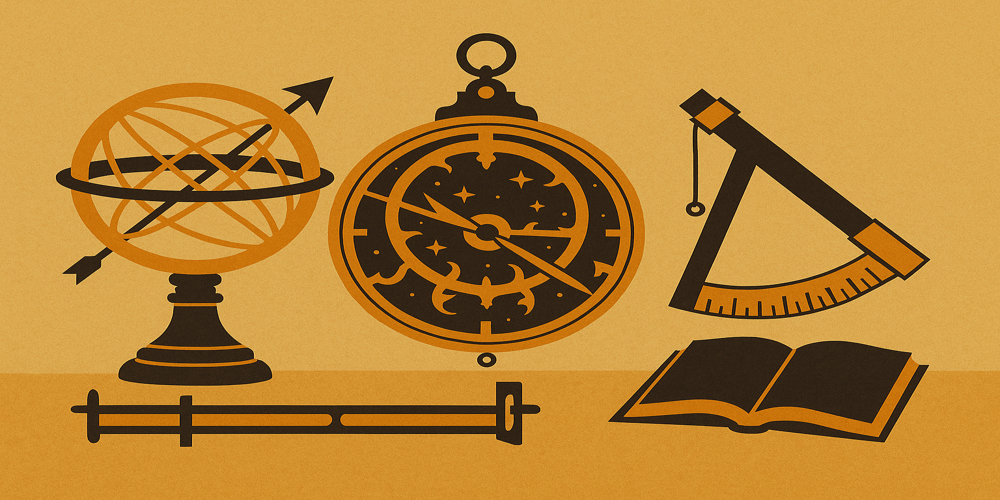لما كانت حضارة الإسلام في عصرها الذهبي حضارة شاملة، فقد أسهمت في علوم الفلك إسهامًا لا يقل أثرًا عن إسهام من سبقهم من اليونانيين والرومانيين والفينيقيين والصينيين. ومن ذلك ابتكارهم لعدة آلات فلكية، أشهرها ما يلي:
1 ـ الإسطرلاب:
الإسطرلاب آلة يونانية يُعزى ابتكارها إلى مدرسة الإسكندرية في العصر الهلينستي (القرن الثاني بعد الميلاد)، وقد طوّره العرب في القرون الوسطى، ومنهم نقله الأوروبيون في العصور الوسطى واستخدموه في الملاحة لقياس ارتفاع الأجرام السماوية.
ووصف الإسطرلاب كما ورد في بعض المصادر العربية: هو عبارة عن قرص معدني مقسم إلى 360 درجة، ويُعرف بميزان الشمس، ومن أجزائه: «العرقة» وهي حلقة يُعلَّق بها الجهاز بحيث يسكن في مستوى رأسي، ثم «العروة» وهي الجزء الذي تُشبك فيه الحلقة، ثم «الكرسي» وهو الجزء البارز من المحيط، ثم «العضادة» وهي المسطرة التي تدور على ظهر المحيط منطبقة عليه ومثبتة في المركز، ثم «الهدفتان» وهما الصنجتان الصغيرتان القائمتان على العضادة بزاوية قائمة، في كل واحدة منهما ثقب يواجه الآخر، ثم «قوس الارتفاع» وهو المرسوم على ظهره المجزأ، ثم «منطقة البروج» وهي الدائرة المقسومة إلى اثني عشر قسمًا غير متساوية كُتبت بينها أسماء البروج. وينقسم تدريج الإسطرلاب إلى 360 درجة، كما أن هناك أنواعًا أخرى منه مقسمة «بالأصابع» بدل الدرجات.
وقد سبق العرب غيرهم من الأمم في صنع الإسطرلاب ودرجوه بدقة منقطعة النظير، ولهم في كيفية صنعه واستعماله مؤلفات كثيرة. وفي مكتبة باريس اليوم إسطرلاب من صنع أحمد بن خلف من منتصف القرن العاشر الميلادي، مرسوم عليه مساقط للكرة السماوية.
ويُعدّد شمس الدين بن عبد الله محمد بن أحمد المزي، المتوفى سنة 750 هـ، في مخطوط له بعنوان “رسالة في العمل بالإسطرلاب”، المسائل التي يمكن إنجازها بواسطة الإسطرلاب، مثل: معرفة ارتفاع الشمس والأجرام السماوية، والميل، والبعد، وعرض البلد، وسعة المشرق، ثم معرفة قوس النهار والليل وساعاتهما وأزمانهما، ثم معرفة مطالع البروج بالفلك المستقيم وبالبلد وتحويلها إلى درجات، كما يمكن به معرفة السمت لكل ارتفاع وعكسه، وسمت القبلة وانحرافها وجهتها، وانحراف البلدان بعضها عن بعض.
وهكذا نرى أن مثل هذه الآلة الصغيرة، التي يمكن أن يحتويها جيب الإنسان، تؤدي عمليات فلكية كبيرة. ورغم أنها ليست في دقة الآلات الفلكية الحديثة، إلا أن استعمالاتها المختلفة تجعل لها وزنًا خاصًّا عند علماء الفلك.
وقد اهتم العلماء المسلمون بالإسطرلاب اهتمامًا كبيرًا لدوره الكبير في تحديد أوقات العبادة، واتجاه القبلة، والكسوف والخسوف، وكذلك دوره المهم في علم الفلك وصناعة الأزياج (الجداول الفلكية)، وتحديد المسافات والقياسات العلمية، وغير ذلك.
2 ـ ربع الدائرة «المربع»:
هو قوس قدره 90 درجة من دائرة الإسطرلاب، مُثبّت عليه خيط يتصل بثقل من الرصاص، ويكوّن هذا الخيط ضلع الزاوية التي تُحدد ارتفاع النجم فوق الأفق. ولاستعماله، يُحرّك الراصد الجهاز بإحدى يديه حتى ينفذ الشعاع الواصل من النجم أو الجرم السماوي بين ثقبين مُثبّتين على إحدى حافتي الجهاز، ويقرأ الزاوية المحصورة بين خيط الثقل والضلع القريب من الراصد.
وقد سبق العرب الأوروبيين بقرون في استعمال الإسطرلاب وربع الدائرة. وأقدم وصف لربع الدائرة في المصادر الأوروبية يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي لمؤلف من مونبلييه، مقتبس من وصف الآلات العربية المماثلة التي كانت سائدة بين الملاحين العرب في البحر المتوسط.
وفي القرن الرابع عشر، وزّع جان الأول أمير أرغون ورائد المدرسة القطلونية في مايوركا للخرائط والكوزموغرافيا على أصدقائه من الأمراء الآخرين في إسبانيا خرائط بورتلانية وإسطرلابات، وقد استُعمل الإسطرلاب من قبل الملاحين البرتغاليين مثل هنري الملاح في منتصف القرن الخامس عشر (حوالي عام 1455 م) أثناء رحلاتهم على الساحل الغربي لأفريقيا. كما استعمل الملاح البرتغالي دييجو جوميز Diego Gomez ربع الدائرة لأول مرة عام 1462 م.
أما الإسطرلاب الذي صنعه البرتغالي ريجيومونتانوس Regiomontanus عام 1468 م، وادّعى المؤرخ البرتغالي دي باروش (عام 1553 م) أنه ابتكار جديد، فهو منقول عن المصادر العربية وليس فيه أي ابتكار.
وحتى في عهد الفتوحات البحرية الكبرى، لم يكن لدى الإسبان والبرتغاليين سوى الإسطرلاب وربع الدائرة لتحديد خط العرض ورصد ارتفاع النجوم في السماء، في الوقت الذي أبطل فيه العرب استعمال هاتين الآلتين، واستعملوا آلات أخرى من ابتكارهم تلائم طبيعة القياس من على ظهر المركب في البحر. والسبب في ذلك أن الرصد بهاتين الآلتين يعتمد على المستوى الرأسي في تحديد أحد ضلعي زاوية الرصد، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأرصاد البرية نظرًا لعدم استواء الأرض وصعوبة إيجاد المستوى الأفقي بدقة. أما الحال في البحر، فالأمر مختلف؛ لأن حركة المركب تجعله غير مستقر، مما يصعّب الاعتماد على الإحداث الرأسي الذي يحدده الثقل والخيط في كل من الإسطرلاب أو ربع الدائرة، مما يجعل القياس غير دقيق.
وأيسر من ذلك اتخاذ الخط الأفقي كضلع من أضلاع زاوية الرصد، وهذا يمكن تحديده بأفق الراصد بسهولة نظرًا لاستواء سطح البحر، ومن ثم فقد اعتمد العرب في قياسهم لارتفاع النجوم على آلات أخرى تتفق مع هذه الفكرة.
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن سودا عام 1912 في كتابه “الملاحة الفلكية عند البرتغال في عصر الكشوف الكبرى” المطبوع في سويسرا، وفيه يقتبس نصًّا من خطاب أرسله الربان البرتغالي جان إلى الملك مانويل ملك البرتغال بتاريخ أول مايو سنة 1500 م، يقول فيه:
“يُخيّل إليّ أنه من المستحيل قياس ارتفاع نجم في البحر بالآلات التي لدينا (الإسطرلاب وربع الدائرة) من على ظهر السفينة بدقة. وثبت من تجربتي أن الخطأ الناتج من قلقلة السفينة في البحر يصل إلى أربع أو خمس درجات كفرق للقياس من الأرض”، ومثل هذا الخطأ يُعد فادحًا في تحديد خط عرض المكان.
كما أنه في المقابلة التاريخية بين فاسكو دي جاما ومرشده الربان المسلم في مالندي، يذكر لنا المؤرخون البرتغال كيف أن الملاح البرتغالي قد أخذته الدهشة حين اطّلع على الآلات التي يقيس بها العرب ارتفاع النجوم، بينما لم يكن لديه سوى إسطرلابات خشبية وأرباع دوائر.
وجدير بالذكر أن أكثر أرصاد البرتغال كانت بملاحظة ارتفاع الشمس نهارًا، ومن ثم فهي أيضًا أرصاد نهارية، بعكس العرب الذين كانت أرصادهم تعتمد على قياس ارتفاع النجوم ليلاً.
3 ـ آلة الكمال:
هي عبارة عن قطعة خشبية على هيئة متوازي مستطيلات، يتصل بها من وسطها خيط مدرّج بعُقَد تختلف المسافات بينها حسب ظل تمام زاوية الارتفاع. ويُلاحظ أن تدريج هذه الآلة يتوافق مع المراحل الملاحية في المحيط الهندي وبحر الصين، بين درجتي 20 جنوبًا و33 شمالاً.
وكان الربابنة يستخدمون خشبات بأحجام مختلفة وفقًا لنوع القياس المطلوب ولمقدار ارتفاع النجم فوق الأفق. ويُقصد بالقياس هنا رصد ارتفاع الكوكب عن الأفق، أو “انحطاطه” بحسب اصطلاح أهل البحر. وأدق القياسات ما كان قطبيًّا، أي قائمًا على القطب، وهو ما يعرف بـ”القياس الأصلي”، بينما يكون القياس أوضح عندما يكون الكوكب قريبًا من القطب.
وأفضل القياسات هي التي تُجرى باستخدام خشبات معتدلة الحجم، لا كبيرة ولا صغيرة، بما يناسب ارتفاع الكوكب أو انخفاضه في مجرى ما بين القطبين. ويُفضَّل ألا تكون الزاوية كبيرة؛ لأن كثافة طبقات الهواء القريبة من الأفق تؤثر على دقة الرصد، كما أن قياس النجوم القريبة من السمت يؤدي إلى أخطاء كبيرة. لذا، فإن الزوايا التي تقل عن 60 درجة كانت الأفضل للرصد، مما دفع الراصدين لاحقًا إلى استبدال ربع الدائرة (90 درجة) بسُدس الدائرة (60 درجة)، وهي الآلة المعروفة حاليًا باسم “السكستان” أو “السدس”، والتي يُنسب اختراعها إلى إسحاق نيوتن.
وقد ألّف المهري كتابًا بعنوان “العمدة المهرية في العلوم البحرية” وضع فيه أربعة شروط دقيقة للرصد:
- الشرط الأول: أن تكون خشبة دبان القياس موافقة لدبان العيون عند استقلال الجبهة، ويكون باقي الخشبات صحيحات القص عليه، ويُعد قياسه جزئيًّا.
- الشرط الثاني: أن يكون البحر وقت القياس أسودَ صافيًا لا يشوبه بياض ولا غبار، ويكون النجم ظاهرًا جليًّا.
- الشرط الثالث: أن يكون قياس ليالي القمر مميزًا، بخلاف ليالي الظلام.
- الشرط الرابع: أن يكون القَيّاس صحيح البصر، فلا قياس لمن اختل بصره.
4 ـ آلة البلستي:
لا تزال هذه الآلة مستخدمة لدى ملاحِي الجزر في المحيط الهندي. وهي تشبه إلى حد كبير الآلات الخشبية المتقدمة، غير أنه استُعيض عن الخيط المعقود فيها بمسطرة مضلعة من الخشب أو الأبنوس، مدرّجة إلى “أصابع”، وينزلق عليها ما يسمى بـ”مربع القياس”، وهو عبارة عن أربعة ألواح مختلفة الحجم. ويمكن استخدام كل لوح مع إحدى واجهات المسطرة المضلعة، إذ تُدرّج هذه المسطرة على أربعة أوجه مختلفة.
5 ـ آلة الأربليت:
وهو نوع آخر من عصا القياس يُستخدم لرصد ارتفاع النجوم أو الشمس نهارًا، ويُشبه إلى حد كبير البلستي. وتُعرف هذه الآلة أحيانًا باسم “الصليب الهندسي”، وأحيانًا أخرى بـ”عصا يعقوب”. وقد استُعملت هذه الآلة لدى الملاحين العرب في جزر الملايف خلال القرن الماضي. ويُعتقد أن البرتغاليين نقلوا فكرة هذه الآلة، وكذلك البلستي، عن العرب في القرن الخامس عشر الميلادي.
وقد شاع بين البحارة الإيطاليين والفرنسيين في البحر المتوسط، قبل القرن الخامس عشر الميلادي، استخدام لفظ كالاميت Calamite للدلالة على “الحُقّة” أو بيت الإبرة المستخدم في ذلك الوقت. والحقيقة أن هذه الآلة لم تكن سوى مرحلة من مراحل تطور البوصلة، التي كانت معروفة في المحيط الهندي سابقًا.
وللإبرة الممغنطة خاصية فريدة، إذ تنجذب نحو الشمال، مما يجعلها أداة فعالة لتوجيه السفن. وعندما تُثبّت هذه الإبرة على حلقة خشبية تطفو على سطح الماء، فإنها تتخذ هذا الوضع الثابت. ولهذا السبب أُطلق عليها اسم “الكلاميت” (الضفدعة)، وهو الاسم الذي عُرفت به البوصلة عند الأوروبيين في بدايات استخدامها في البحر المتوسط.
وقد أطلق الأنجلوساكسون على البوصلة الملاحية اسم Compass. أما كلمة “قنباص” أو “قمباص” التي استُعملت عند العرب، فكانت تُطلق على الخرائط البورتلانية المستخدمة في البحر المتوسط آنذاك، والتي تُرسم عليها الاتجاهات الملاحية بخطوط متوازية ومتقاطعة مع خطوط الرياح وغيرها.
وقد ذكر ابن خلدون هذا المصطلح في مقدمته، أي قبل ظهور ابن ماجد بقرن من الزمان، كما أشار ابن فضل الله العمري المتوفى عام 749 هـ (1347م) في كتابه “ممالك الأبصار في مسالك الأمصار” إلى أن هذا اللفظ (قمباص) معرّب من اللاتينية.
المصادر:
أنور عبد العليم، الملاحة وعلوم البحار عند العرب، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1979م
طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، ط 1، بيروت، 1985.
عباس العزاوى، تاريخ علم الفلك في العراق، المجمع العلمي العراقي، بغداد 1958.
عبد العظيم أحمد عبد العظيم، الكشوف الجغرافية، مكتبة الإسراء، الإسكندرية، 2021م.
عبد العظيم أحمد عبد العظيم، الفكر الجغرافي، مكتبة الإسراء، الإسكندرية، 2022م.
كرلو نيللينو، مادة اسطرلاب، دائرة المعارف الإسلامية، دار المعرفة، بيروت، 1933.
مخلص عبد الحليم الريس، تاريخ علم الفلك منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ط 1، دار دمشق، دمشق، 1984.