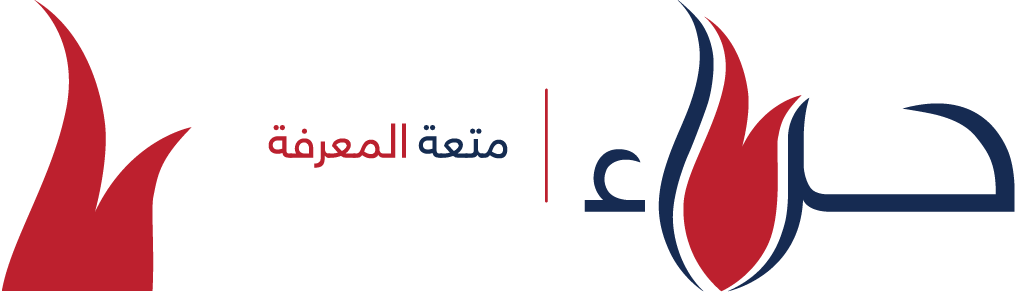يُعد مفهوم الحداثة الشعرية موضوعًا إشكاليًّا في الشعر العربي، وتناوله يشكّل وجبةً ثقافيةً دسمةً نظرًا لاختلاف الرؤى بين المدارس الشعرية المتنوعة، وكذلك لارتباطه العميق بين القراءة الوجدانية وإسقاطها المعرفي على واقع جديد بأدوات مغايرة. ولأنّه مفهوم يُفهم في الوهلة الأولى على أنه مفهومٌ زمنيّ، إلا أنني أرى أنه في جوهره مفهومٌ رؤيويّ، تحرّريّ، وانعتاقيّ، يمثل الحرية التي تُولد من رحم الواقع، لا بمعنى الانفصال عنه. إنه بناءٌ تجديديّ، لكن من داخل الوطن الشعري، لا من خارجه.
وعلى الرغم من أن كثيرًا من روّاد حركة الحداثة اعتبروا الحداثة ثورةً على البناء الهيكلي للقصيدة العربية التقليدية، فإنني أرى أن الحداثة يمكن أن تُبدع عالمًا جديدًا، مبتكرًا، ومدهشًا، من داخل القالب الشعري العمودي، دون أن تكون بالضرورة عملية هدم لذلك البناء. فالحداثة ترتبط بالقدم كما ترتبط بالتراث؛ فلا حداثة دون جذور، ولا ثمار دون أصل.
ومن هنا، ينبغي أن تستمد الحداثة كامل جوهرها وإشاراتها وتطلعاتها ووجودها الوجداني والفكري والفلسفي والرؤيوي والحضاري من التراث. فبدون هذا الارتباط، تصبح الحداثة انقطاعًا عن الدورة الدموية الشعرية العربية، ونداءً في فراغ لا يسكنه أحد، وبيتًا بلا أساس ينهار عند أول عاصفة حوارية فكرية ينطق بها لسان العالم الآخر.
وإذا كان لا بد من عصرنة القصيدة العربية، فهل يمكن للعصر الحديث أن يُنكر صلته الروحية والوجدانية بتراثه؟
هل يمكن أن ينسى الطفل أباه وجده؟
كذلك هي علاقة الحداثة بالتراث: علاقة الطفل بأمه وأبيه وذكرياته التي تشكل مسكنه الحقيقي ومنبته الأصلي.
هل الحداثة مفهوم يرتبط بالزمن؟
إذا نظرنا إلى المفهوم السطحي الظاهري للكلمة، فإن القارئ العادي قد يربط الحداثة بالزمن. ولكن “الشعرية” التي تُضاف إلى الحداثة تشعل طاقةً روحية في ذلك البحر العميق، الذي تعبره سفن الذهول المتماوج، المتصل بضفاف المعنى وشواطئ الابتكار، لتُشكل صعودًا وهبوطًا دائمًا، وكيمياء لا تنفد عناصرها المتفاعلة، وشحنات تتجدد تلقائيًّا مع كل بحّة ناي في الأعماق، أو صرخة طفل مختبئ في زوايا الصدر.
وهذا يؤكد أن المياه الشعرية الحداثية هي امتدادٌ فكريّ لا ينقطع، مع تكثيف بلاغي للفكرة في صورة مختلفة، وعبارات لفظية تقترب من البيئة الروحية للشاعر المتمسك بذاتيته، التي لا تنفصل عن كونها جزءًا لا يتجزأ من قراءة وجدانية ثقافية ممتعة لمحيطها. وتلك هي “الذات الصغرى” المنبعثة من “الذات الكبرى” للإنسان بكليته.
وهذا التدفق، ومما لا شك فيه، يُؤكد أن الحداثة ليست مفهومًا زمنيًّا كما أُشيع. ودليل ذلك هو تجربة أبي نواس وأبي تمام الحداثية المتفق عليها زمن العباسيين، من حيث الفكرة والصورة والاستكشاف والتحليق في عوالم لم تكن مألوفة قبل ذلك، وما زالت مصدر اهتمام الباحثين في علم الحداثة.
وأبلغ مثال على ما قلتُه هو ثورة أبي نواس على الأطلال واستبدالها بالخمر، حين قال:
“صفةُ الطلول بلاغةُ القِدمِ … فاجعلْ صفاتَكَ لابنةِ الكرمِ”.
الحداثة تمثل ألوان الطيف الوجداني
بالعودة إلى تواتر الفكرة، وموسيقى الكلمة، وبراعة اللون، وإذا نظرنا إلى المشهد الشعري بوصفه سحرًا جذابًا ومركزًا لدائرة العمق التأملي والفلسفي، فإننا ندرك أن تفعيلة النبض التي وُلدت من رحم القصيدة العمودية تُشكل انفتاحًا يفتح جهات الرؤى، وساحات الاستكشاف، لتنثر من عبق أصالتها نفحات أرجوانية في فضاءٍ عطشٍ للعناق مع عصافير الكلمة المشعة حضورًا وبهاءً.
هذا الطيف الناطق من ضوء الشعر يُشكل فسيفساء خالدة، بتنوعه اللوني، وطاقته، وتأثيره المدهش.
لذلك أقول: إنه المنبرُ المتجاوزُ عشقًا للمنابر الخشبية، الممتد شوقًا إلى الفسحة الضوئية، الغارق في عالم من اللهفة المرسومة بريشة تتنقل بين المدارات الطائرة بلا ضجيج، وعليه فإن الشغف الهاطل بين أجنحة العصافير، والنسيم النائم على وسادة الحلم، وتلك الصور المشتعلة في الوجدان، المنثورة عطرًا على أسطر النهدات، هي بث غير مباشر لما يعتلج في النفوس الشاعرة.
علاقة الحداثة بالشكل
لا شك أن البعض ممن اقتربوا من مفهوم الحداثة، ظنوا خطأً أن الحداثة هي التفاف على شكل القصيدة، باعتباره قيدًا يقف في وجه الامتداد اللامحدود للفكرة. لكن الحداثة بجوهرها المنفتح، رؤية واسعة المدى، يمكن تكثيفها في لقطة شعرية فائقة الدهشة، وقد تسكن في كوخٍ قديم بمتعةٍ لا نهائية، أو تفترش أرصفة النجوى بلهفة لمعانقة الطريق، أو تمرح مع غزلان الضوء، وتفك أزرار المشاعر لتنتعش من نسيم الطبيعة الساحرة.
تلك هي رؤيتي لإشكالية الجسد التعبيري للقصيدة؛ فلربما تجلس على كرسي خشبي بكامل الانتعاش، ولا يُسعدك قصر فارِه.