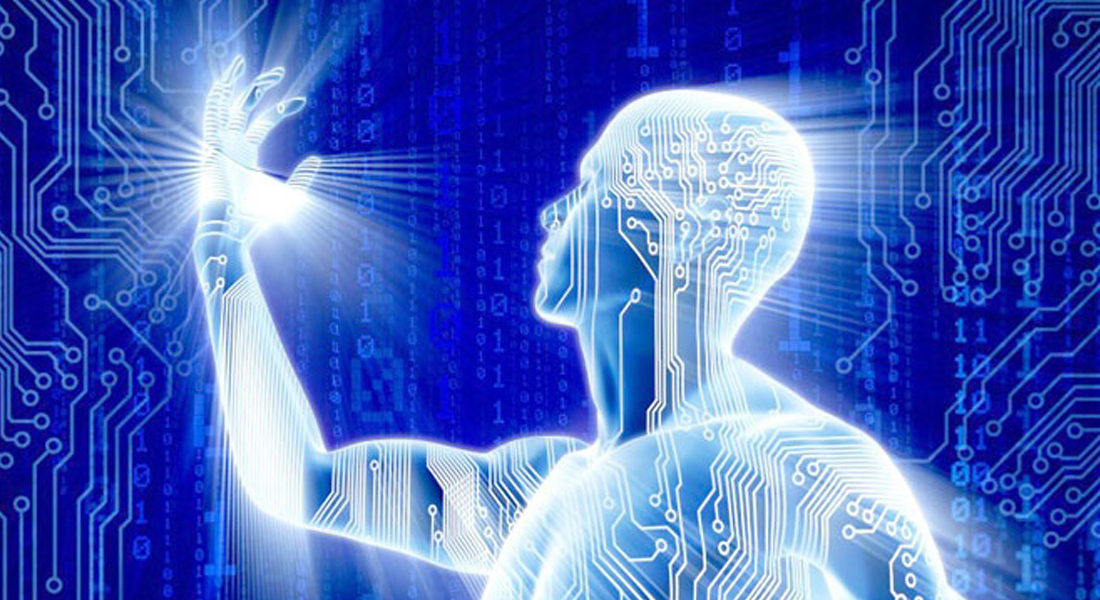في ظل أزمة ما يعرف بالمصطلحات الدخيلة على ثقافتنا نحن المسلمين قفزت عدة كلمات تراكبت معًا لتمثل مصطلحات غاية في الخطورة والقبح.
فبعد الترويج لما يسمى بـ”الخيانة المشروعة”، وتبادل الزوجات، وانتهاك حرمة المرأة تحت مسمى مواثيق حقوق النساء، بات من السهل تقبّل مصطلحات أخف وطأة من مثل “انتهاء الصلاحية”، وهذا المصطلح برغم أنه لا يبدو مستغربًا بين الأوساط على جميع انتماءاتها الفكرية والثقافية، فإنه يحمل من القسوة الكثير؛ كونه يؤصل لفكرة الإقصاء والاستبعاد دون جريرة.
“انتهاء الصلاحية” مصطلح يوصف الرجل به المرأة على السواء في مرحلة ما، عندما يرون ألا فائدة من أحدهما، وإن شاع استخدامه للرجل بحكم كونه الأكثر تفاعلا واندماجًا في المجتمع.
ويدور هذا المصطلح حول معنى أن فلانًا بات لا فائدة منه في هذه الحياة ولا يرجا منه نفع حيث فقد دوره في الحياة وكل ما عليه -في نظر من يطلقون هذا اللفظ- إلا أن ينتظر الموت، في مقابلة آخر لا يزال يعطي ويمنح فهو لا يزال في فترة “الصلاحية”.
وبالنظر في الاستخدام الدارج لـ “انتهاء الصلاحية” يتبين أنه مصطلح دخيل على ثقافتنا، وهو أليق بالمنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المستهلَكات بخلاف الأشخاص، كونهم مكرمين ولا يستساغ تشبيههم بالمستهلكات من الأشياء والأدوات.
وبالتدقيق حول أسباب إطلاق هذا المصطلح على آخرين يظهر أنه تكاد تنحصر في انتهاء دور أشخاص في إنجاز أمر معين، ولم يعد لهم فائدة بالنسبة بأن يكون انتهى عقد عملهم، أو لم يصبحوا بالكفاءة المرجوة أو غير ذلك، كما أن بعض النساء تطلقه مجازًا على الزوج الذي لا يهتم بشؤون أسرته ولا يقدم لزوجته الاحترام والتقدير؛ فضلا على استطاعته منحها حقوقها الشرعية فيصير من وجهة نظرهن “منتهي الصلاحية”، في حين يستسهل البعض (استخفافًا) إطلاقه على كبار السن الذين لم يعد بمقدورهم المنح والعطاء لظروف تفوق قدرتهم وإرادتهم بحكم الكبر.
وبالنظر إلى ما الإسلام وما أثبته من كرامة للإنسان في جميع أحواله لاسيما في لحظات الضعف وعدم القدرة على العطاء لظروف تفوق طاقته نجده يأمر بالرفق ويحث على حسن المعاملة واحتمال الضعيف وإكرامه ولا يساويه بالآلات كما يسوغ البعض، فأيًا ما كان سبب الإطلاق فإن هذا المصطلح غير لائق (أخلاقيًا)، فلقد خلق الله الإنسان دائما معطاء يعطي ويمنح فلا ينبغي عندما تتعسر قدمه أو تكبر سنه أن نسمه بما نسِم به الجمادات بأنه عديم النفع عالة على المجتمع لا فائدة من وجوده.
لقد حق الإسلام على إكرام الغير وحسن معاملته أيا كان معتقده، وأيا كان وضعه حتى إن أساء إلينا أن نلتمس له العذر ونوجه ولا نقابل السيئة بالسيئة، ولكن نعفو ونصفح ما وسعنا ذلك، وتتجلى هذه المعاملة الراقية مع الإنسان في لحظات ضعفه كون والحالة هذه يحتاج من يرفع معنوياته ويساعده ويشعره بالأمان وأنه لا يزال مرغوبًا فيه، محتاجًا إليه نأنس برأيه؛ فهو إذًا موجود، وله دور في الحياة، نستشيره بحكم ما لديه من خبرة، ونرجع إليه بحكم ما لديه من تجربة، ولا يمكن أبدًا أن نستغني عنه؛ إذ حاجتنا إليه أكثر من حاجته إلينا، وكل يعكس جانبا من الوفاء له ولمسيرة عطائه على مر الأيام.
وإذا كان هذا الاهتمام بالآخر عامًا يشمل الجميع فإنه لذوي القربى آكد وأبين لاسيما الوالدين، فمن يستسيغ أن يَصِمَ أباه أو أمه ولو على سبيل التندر والمزاح بهذا اللفظ الجارح؟! لقد أوجب الإسلام للوالدين حقوقًا لا تنازل عنها؛ فقرن الله الإحسان إليه سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما، فقال:(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا…). (الإسراء:23)
ولهذا الإحسان صور غير محصورة من التقدير والعناية بهما واسترضائهما، والتودد إليهما، والإذعان لهما، والانقياد لأمرهما، وعدم التأفف منهما، ومواصلة الدعاء لهما بالرحمة: (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).. وكل هذا يصطدم بكل حال وعلى أي وجه من وصمهم بــ “انتهاء الصلاحية”.
ولم يقف الإسلام عند الإحسان بالوالدين فحسب بل رغب أيضًا بحسن معاشرة الزوجة زوجَها، وطاعته في المعروف، والتلطف معه والتودد إليه، ويؤكد هذا ما رواه أحمد والحاكم عن الحصين بن محصن: أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم قال: كيف أنت له ؟ قالت ما آلوه (أي لا أقصّر في حقه) إلا ما عجزت عنه. قال: “فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك” أي هو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّه، وسبب دخولك النار عن قصّرت في ذلك. (والحديث جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1933)، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وإن كان في إسناده كلام- أنه قال: “اتقوا الله في الضعيفين: المرأة الأرملة، والصبي اليتيم” أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس، ومن حسن العشرة بين الزوجين عدم إفشاء السر، والتزام الذوق، وخفض الصوت ، واحتمال الأذى والعجز، وفي هذا ما لا يخفى من التعارض مع وصف أحد الزوجين للآخر بأنه منتهي الصلاحية لا فائدة منه خاصة إن كان ما طرأ عليه له فيه عذر خارج عن إرادته كعجزه عن السعي لمرض ألمّ به، أو كبر أقعده.
وينطلق الإسلام ليفتح طريق الإحسان لكل الضعفاء والمرضى والمعوذين والمحاويج؛ فلقد عني الإسلام بذوي الإعاقة وكبار السن واليتامى والمستضعفين في الأرض ومن يلزم إعانتهم ورغب في الإحسان إليهم، ففي اليتامى أمر بالإحسان إليهم وكفالتهم ورعايتهم وحسن تربيتهم وحفظ مالهم، قال -صلى الله عليه وسلم-: “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين”. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّج بين أصابعه، أيضًا جعل الله الإحسان لليتيم طريقاً للفوز والنجاة من عذابه فقال: (فَلاَ اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ) [البلد:11-16]، كما جعل ازدراءه وإهانته لا تتفق وسبيل المتقين فقال: (كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) [الفجر: 17، 18]، حتى إيلامه نفسيا بالقهر نهى عنه الإسلام فقال: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ) [الضحى:9]، والمر بإكرامه والإحسان إليهم يتعرض مع النظر إليهم بفوقية واعتبارهم عالة على المجتمع.
الأمر نفسه دعا إليه الإسلام مع كبار السن؛ فعَنْ عَائِشَة رضى اللهُ تعالى عنها أَنَّها قالت: “أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ”. وثَبتَ عَنهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قالَ: “مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا” رواهُ أبو دَاودَ. وثَبتَ عَنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: “إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ” رواهُ الإمامُ أَحمدُ.
وزاد من اعتناء الإلام بهذه الطبقة (كبار السن ) أن اعتبرهم سببا في النصر والرزق لنا؛ فلقد جاء في حَديثِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ” رواهُ البخاريُّ.. فأي فضيلة هذه وأي درجة عالية تلك التي أكرم الإسلام بها هؤلاء.
وفي المرضى والضعفاء وذوي حاجات راعى الإسلام ظروفهم وحث على جبر خواطرهم فهذا عتبان بن مالك الأنصاري – رضي الله عنه – وكان أعمى لا يبصر- يقول: وددتُ يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى (وكان بيته بعيدًا)، فما كان من رسول الله إلا أن وعده جبرا لخاطره ومراعاة لظروفه وحتى يشعر بالفائدة والأهمية، فوعده صلى الله عليه وسلم بزيارة وصلاة في بيته.
يقول عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنتُ له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: “أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ”، فأشرتُ له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر فقمنا، فصفنا، فصلى ركعتين، ثم سلم. (رواه البخاري ومسلم).
وهذا أنس رضي الله عنه يروي لنا حديثًا عن رسول الله، أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة! فَقَالَ: “يَا أُمّ فُلاَنٍ! انظري أَيّ السّكَكِ شِئْتِ، حَتّىَ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ”، فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها .رواه مسلم.
وقد حث الإسلام على عايدة المريض ورفع معنوياته والدعاء له ووعد على ذلك بجزيل الأجر والمثوبة لبث روح التكافل والتعاضد بين المسلمين وبعضهم، وبغيرهم في المجتمع الواحد؛ فقد رواه مسلم في صحيحه عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.
وهكذا تجلت عناية الإسلام بمن يراه البعض عديم الفائدة لا جدوى لوجوده منتهي الصلاحية لكونه من الفئات المستضعفة أو كبار السن أو غيرهم، مما يؤكد حضارية الإسلام وإنسانيته، في مواجهة أقوام راحوا يساوونه بالجمادات، على أن بعدًا آخر وهو أن الإنسان وعلى مدار التاريخ هو من يحدد انتهاء صلاحيته، فقد تنتهى صلاحيتك في مكان ما، أو في زواجك، أو غير ذلك مما تظن فيه الاستمرار لتتفتح لك طرقًا أخرى للعطاء في موضع بديل.. وبهذا ينبغي أن يتجدد لدى الضعفاء اليقين فما ضاقت إلا فرجت وإن مع العسر يسرًا.. كما يتجدد لدى الجميع احترام الآخر وعدم إقصائه واستبعاده ووصمه بأوصاف لا تتفق وما يدعو إليه الإسلام.