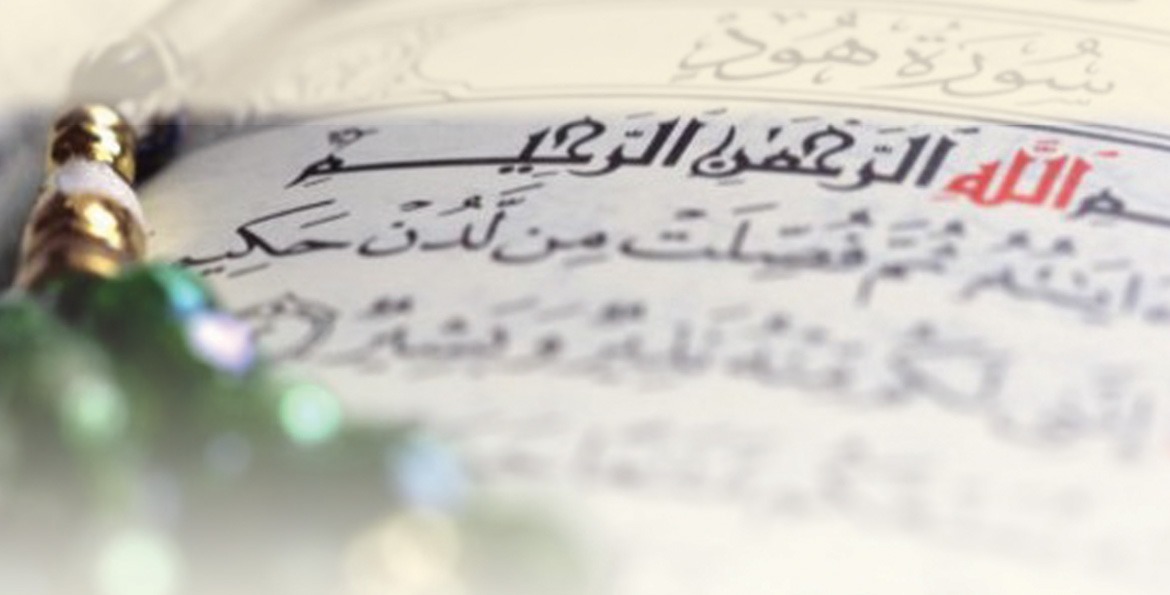هل صحيح أن العلم البشري -نظرًا لنسبية تصوراته وتغير معطياته- لا يصلح لتفسير القرآن؟ وإلا فكيف يمكن له -في ضوء تجدد معارفه- أن يُسهم في توسيع الفهم الصحيح لمعاني الآيات، ومن خلالها في تدعيم علاقة التفاعل القائمة بين الفكر والذكر دون المساس بالقواعد الشرعية والثوابت الفكرية؟
لا غرو أن القرآن الكريم هو كتاب معجز لا يمكن تفسير كلامه التفسير المطلق، لا بالعلم ولا بالبلاغة ولا بالمنطق ولا بالبيان ولا بأي إدراك معرفي بشري، اللهم إلا بصحيح الإسناد المتصل إلى رسول الله لأنه كان موصولاً بالوحي، وما عدا ذلك -مهما كان فيه من التنوير- لا يمكن وضعه إلا في موضع التفسير النسبي، نسبة إلى مستوى الإدراك المعرفي للمفسر الذي تصوغه ظروف ومعطيات الزمان الذي كان فيه.
أما ما يمكن أن يقدمه العلم البشري بخصوص فهم القرآن، فليس بالضرورة تفسيرًا علميًّا بقدر ما هو توسيع في الفهم ببيان ما تحمله آياته من إشارات علمية وأسرار لم تكن لتظهر لولا استجلاء العقل لها، واستظهاره في كل زمان لمدى التوافق الباهر بين حقائق العلم التي يصل إليها الإنسان، ودلالاتها في الإشارات التي جاء بها القرآن. وكأن لسان حال العلم البشري -بتطوره العقلي وتقدمه المعرفي- يقول إن تلك الإشارات الكونية التي تنزّل بها القرآن، والتي فُسرت في ذلك الزمان بمعطيات علومه، كانت منذ ذلك العهد تحفل بأسرار ما كشفت عنه علوم هذا الزمان، إلا أنها كانت في دائرة الغيب النسبي نظرًا لاحتجاب الحقائق العلمية آنذاك، فأصبحت في الزمان الذي نحن فيه نظرًا لرفع الحجُب في دائرة عالم الشهادة، وذلك سر إعجاز هذا الكتاب.
القرآن يستوعب كل اكتشاف علمي
فإعجاز القرآن كما ذكرته مصادر كثيرة -وأذكر منها كتاب “الشفا”- أدركه الإنسان على أوجه متدرجة مع تطور مداركه المعرفية عبر الزمان. فأول ما أبهر الإنسانَ في القرآن إعجازُه البلاغي، وهو المتعلق بفصاحة كلامه ودقة بيانه نظرًا لما كان عليه لسان العرب آنذاك من بلاغة وفصاحة. ثم انبهر الشعراء بإعجاز القرآن البنائي، حيث أبهرهم بروعة نظْمه وإحكام وزنه ورقة أسلوبه. ثم ما لبث أن التفت الإنسان إلى إعجاز القرآن الإخباري، حيث انبهر أهل الكتاب لوجه إخباره بأسرار كتبهم وأخبارهم وأخبار من قبلهم، وبقصص ما كان من القرون السالفة منذ بدء الخلق إلى الأمم البائدة إلى الحضارات الهالكة، مما بقي أو لم يبق منه أثر، بل وحتى بقصص أشخاص ذُكرت أسماؤهم ولم يبق من آثارهم شيء. ثم وقعت أحداث هامة ووقائع طبعت التاريخ فجاء وقوعها على تمام ما أخبر به القرآن، فانبهر الناس لإعجازه الغيبي وإخباره بمغيبات لم تكن وقعت بعدُ، ثم حدثت كما أخبر بها القرآن؛ كفتح مكة، وغلبة الروم، وباقي الفتوحات التي عرفها المسلمون. كما تعهد سبحانه بإظهار آياته في الآفاق وفي الأنفس، مصداقًا لقوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)(فصلت:53).
وجاء زمن العلم والتكنولوجيا والذرة وغزو الفضاء، ليجد الإنسان نفسه أمام ظواهر علمية بالغة التعقيد، لا يوجد كتاب أحكمُ في الإشارة إليها، ولا أدق في التعبير عنها من القرآن المجيد، بحيث كلما صاح العلم بجديد مكتشفاته، إلا ووجد في القرآن ما يشير إلى دلالاته، بل ووجد الباحثون ما وصفوه وصنفوه في بحوثهم من تلك الظواهر قد استوعبه القرآن، واختزله في إشارات غاية في الإيجاز والإعجاز، وبالغة في الدقة ومحكمة في التركيز.
فالإنسان لم يفهم دلالة كثير من الإشارات الكونية الواردة في القرآن، إلا من بعد ما جاءت الاكتشافات العلمية مبيّنة تفاصيلها؛ بحيث تكلم كتاب الله سبحانه وتعالى عن “فتق الرتق” عند بدء خلق السماوات والأرض، وعن “بناء السماء” وجعلِها سقفًا محفوظًا، وعن ظاهرة “التوسع” فيها، وعن وجود “الحبك” فيها، وعن “تزيين السماء الدنيا بالمصابيح”، وما إلى ذلك مما أقرّتْه أحدث الدراسات العلمية لأكبر وكالات الاستكشافات الفضائية.. بل واستعملت في تقاريرها نفس المصطلحات التي وردت عن تلك الظواهر في القرآن. وهي المصطلحات التي لم يكن للإنسان أن يفهم معانيها لولا تبيان هذه البحوث العلمية لها؛ بحيث لم يتبين الإنسان -مثلاً- مغزى قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا)(الشمس:4)، والكلام عن الشمس، إلا من بعد ما غزا الفضاءَ، ورأى الشمس كنقطة ضوء يغشاها ظلام الكون الحالك. كما أنه حار -مثلاً- في فهم معنى قوله تعالى: (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ)(الطور:6)، علمًا بأن الماء والنار ضدّان لا يلتقيان، فكيف بالبحر أن يُسجر بالنار! إلا من بعد أن صورت له الرحلات الاستكشافية لأعماق البحار، قيعانَ المحيطات وهي مشتعلة بفوران البراكين، التي تتدفق بالحمم النارية عند أحزمة الصدع الفاصلة بين قطع سطح الأرض المتجاورات. هنالك تَبيَّن له معنى قوله تعالى: (وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ)(الطارق:12)، وقوله كذلك: (وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ)(الرعد:4).. فتجلى له من خلال ذلك، مشهدُ تسطيح الأرض كآيات دالة على إعجاز هذا الكتاب الذي أورد الاستفسار عنه منذ زمن التنزيل في قوله تعالى: (أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)(الغاشية:17-20)، وكأن ذلك الاستفسار كان موجهًا لأهل هذا الزمان.
وجاءت الدراسات الجيوفيزيائية -الجد معقدة- بتفاصيل ما لم يتمكن الإنسان من إدراكه، لتُجسِّد لنا الجبال أوتادًا، تمامًا كما ذكرها الله في قوله تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا)(النبأ:6-7).. تلك الإشارة التي نزلت في مجتمع بدائي، وفي زمن لم تكن لأهله من مقومات العلوم، حتى أبجدياتها، مما يعني أن تلك الإشارات القرآنية ومثيلاتها، كانت منذ ذلك العهد -وما تزال- مجالات بحث مفتوحة لمعطيات كل زمان، لا تنقطع عجائبها ولا تنقضي غاياتها، بل تتجلى على كل زمان بقسط معلوم من أسرارها. فهل بعد كل هذه التجليات العلمية يستطيع أحدٌ اليومَ، أن يلجم العقل ويمنع العلم من الإدلاء بإسهامه في توسيع فهم آي القرآن، وتجديد معانيها بقواطع الحجة ودلائل البرهان؟
تجديد الفهم لمعاني الآيات القرآنية
لا شك أن الحقائق العلمية التي وصل إليها العقل البشري، تُشكّل أرضية صلبة وأساسًا قويًّا في بناء الفهم السليم للقرآن الكريم، بل وحتى النظرية العلمية لا يمكن الاستهانة بها، لأنها منطلق الأساس في بناء الحقيقة العلمية. والقرآن، لمّا فتح باب البحث أمام الإنسان أوّل ما دعاه إليه، النظر: (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)(يونس:101)، (قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ)(العنكبوت:20)، في إشارة إلى أن النظرية التي هي أوّل ما ينتجه البحث المتمخض عن خطوات الملاحظة والفرضية والتجربة، ما تلبث أن ترقى إلى مستوى الحقيقة بعد إثباتها بالبراهين ووقوع الإجماع العلمي عليها. فقانون الجاذبية، أول ما تم اكتشافه -وكان ذلك على يد إسحاق نيوتن، علمًا بأن ابن طفيل من خلال نظرته التكاملية بين العقل والوحي، قد سبقه إليه بقرون- كان مجرد نظرية منبثقة من ملاحظته سقوط تفاحة من شجرة، ثم ما لبث أن ارتقى بإجماع أهل الاختصاص إلى مستوى الحقيقة العلمية، فصار قانونًا معتمدًا لكل الدراسات الفيزيائية المهتمة بمجالات القوى. والقرآن سبق الإشارة إليه منذ زمن الوحي في قوله تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا*)(المرسلات:25-26)؛ حيث تعني كلمة “كِفَاتًا” كما جاء في التفاسير، ضامة وحاضنة لكل ما عليها، أي كل ما على الأرض منجذب إليها.
مما يُظهر أن الحقائق العلمية هي أدوات رزينة، تمكّن الدارس لكتاب الله من تجديد الفهم لمعاني الآيات بتجدد المكتسبات العقلية وتوسّع التجليات الفكرية. ويُظهر من جهة أخرى، أن القرآن الكريم هو كتاب علم لكن ليس دليلاً علميًّا، لأنه بدعوته إلى البحث والنظر، يكون فتح لنا باب الفهم الذي يشغّل العقل. ولو أنه شمل الإجابة عن جميع الأسئلة العلمية، لكان سد باب العقل وفتح باب النقل، وهو ما لا يتفق مع دعواته المتكررة التي جاءت في صيغ (أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)، (أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ)، ومع حثه الإنسان على البحث والتنقيب في أسرار السماوات والأرض، كما جاء ذلك مقررًا في كثير من الآيات.
فابن كثير الذي يعتبر مرجعًا في تفسير القرآن، فسّر كثيرًا من الآيات الكونية باجتهادات عقلية وتصورات فكرية. ولا أدل على ذلك من تفسيره لقول الله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلاَ يُبْصِرُونَ)(السجدة:27)؛ حيث ذكر -رحمه الله- أن أرض مصر مُرادة في هذه الآية، لأنها كما قال: “أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرًا لتهدمت أبنيتها، فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيه طين أحمر، فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين -أيضًا- لينبت الزرع فيه. فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم، وطين جديد من غير أرضهم، فسبحان الحكيم الكريم”. هذا التفسير كما يظهر من مضامينه، يدل على أن المفسر استند إلى معطيات علمية منبثقة من اجتهاد عقلي متجدد، لأن فهم أثر الماء على مختلف هذه الجوانب، يحتاج إلى معرفة علمية واسعة. كما أن الماء ليس وحده الأساس في إنبات الزرع، بل الطين أيضًا -كما جاء في التفسير- بما يحمله من مواد معدنية مخصِّبة مجلوبة من تعرية الأراضي التي يمر عليها الماء. وهو ما يثبته العلم حاليًّا بعدما تكشّف منبع النيل من بحيرة “فيكتوريا” المحاطة بأعلى القمم البركانية لوسط أفريقيا التي تُمد النيل بشتى أنواع المعادن. مما يُظهر أن المفسر لم ينحصر علمه فيما جاء به النقل فقط، بل تعدّاه إلى استعمال العقل، والبحث في علوم زمانه على اختلاف أنواعها.
تفسير القرآن بالقرآن
وهذا نجده كان السائدَ في معظم القرون المشرقة من تاريخ الأمة، حيث كان تفسير القرآن يرمي -بالإضافة لإقرار المأثور- إلى بيان معاني الآيات بتوظيف مدارك العصر العلمية، مما لا يتعارض مع القواعد الشرعية. فالآيات المكية التي تنزلت متضمنة ذكرَ الخلق وأطواره، والكون وأسراره، والحياة وحقيقتها، والأرض ومكوّناتها، والبحار ومكنوناتها، فرضت على العقل التحرر من رواسب الجاهلية وتصوراتها الخرافية، ودفعت به في اتجاه توسيع المدارك العلمية قصدَ تأسيس فكر علمي قادر على فهم القرآن فهمًا يتناسب ومستجدات الزمان.
فكان تفسير القرآن بالقرآن، حيث فهِم الناس كثيرًا من الظواهر العلمية بالقرآن، وفسّروا كثيرًا من الآيات من منطلق ما فَتَح اللهُ عليهم بالقرآن، فأشرقت أنوار المعارف في قلوبهم بسلامة الفطرة، وتلاقى عندهم العقل مع النقل، بحيث -ورغم احتجاب معظم الحقائق العلمية في تلك القرون- لم يته المفسّرون في فهمهم للآيات، بل توافقت تفاسيرهم قياسًا على ما رأوا من المخلوقات والظواهر، وما وصلهم من أخبار الوحي مع كثير مما جاءت به علوم هذا العصر، لا لشيء إلا لكون القرآن هو نفسه يعطي الإنسانَ المفاتح الضرورية لفهمه، مصداقًا لقوله تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)(الإسراء:9)، إذ يُحدث تدبّرُ آياته تفتّقًا للعقل، يجعله يندفع بتلهف للبحث في معانيها. وذلك ما تعهّد به ربنا الكريم في قوله: (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)(القيامة:18-19).
أما اليوم وقد رُفعت عن كثير من الحقائق الحجبُ، وانجلت عن مفاهيمها السحبُ، بات لزامًا علينا أن نزداد فهمًا للقرآن بأن نقرأه قراءة معنى لا قراءة لفظ، لأن اللفظ ميّت مع الزمان، ولكن المعنى حي متجلّ مع تجدد علم الإنسان؛ وأن نقرأه بعيون الحاضر لا بعيون الماضي، محاولين من خلال ذلك ألا نحصر معانيه في زاوية أسبابٍ نراها ارتبط نزول الآيات بها وقد لا تكون إلا من قبيل الملابسات التي أحاطت بجوانبها. فذلك يحصر آيات القرآن بين سطور التاريخ، وهو ما لا يتفق مع إعجازه الذي لا يحد بزمان ولا بمكان؛ وأن نستشعر قوته على استنهاض العقل، ملتمسين من خلال ذلك الوصول إلى المعنى الذي أراده الله، ذلك المعنى الذي لا تكتمل حقيقته إلا بتجميع الدلالات من متفرق الآيات، كشأن الصورة المشتتة أجزاؤها في مواضع متفرقة، لا بد لكي نعيد تشكيلها على وجهها الحقيقي، من أن نجمع أجزاءها كلا في موضعه المنسجم مع الآخر والمكمل له. فالله تعالى لمّا فتح باب الفهم للإنسان، أراد من خلال ذلك أن يبيّن له أن هذا الكتاب الذي هو معجزة كل زمان، لا تنقطع أسراره مهما سبر العلمُ أغوار الأكوان، وأن ذلك الكون الذي هو دليل الإنسان، إنما جعله سبحانه مرجعًا تجريبيًّا له، لعله يصل من خلاله إلى فهم مضامين القرآن.
وهذا ما يجب أن يستحضره كل متطلع بعلم إلى فهم القرآن، لأن العلم هو في الحقيقة حلقة مغلقة كلما دار الإنسان في فلكها بعقله متفكرًا، أرجعتْه شوارق أنوارها إلى القرآن متذكرًا، وكلما جال في آفاق القرآن بوجدانه ذاكرًا، أحاله ذكره على الأكوان متفكرًا. فكان ذلك دليلاً له على أن هذا القرآن الذي فُصّلت آياته محْكماتٍ، يستدعي فهمُه سبرَ أغوار الأكوان، وأن هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل محكمَ البناء متناسقَ العلل، إنما جعله سبحانه مرجعًا تجريبيًّا للإنسان، لعله يستدل به على تصوراته الفكرية ومفاهيمه العلمية، فيؤسس على ضوئها النماذج التفسيرية، والأنساق البيانية الموصلة إلى فهم المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من القرآن، لا المعنى الذي يريده الإنسان.
ومن هنا يمكن للبحث العلمي أن يسهم في توسيع فهم كتاب الله عز وجل، ليس من باب الخوض فيما جاء به السلف نسْخًا أو تعرّضًا، ولكن من باب تحديث ذلك الموروث فهمًا وتجددًا، لأن المسلم في خضم الجدل القائم في هذا الزمان بين دعاة العقل وأهل النقل، وفي دوامة ما يعيشه العالم اليوم من تفجر للمعلومات وتصادم بين الأفكار والمعتقدات، لا يمكن له أن يجد موقعه للدعوة إلى الله إلا من منبر فكر عقلاني متنوّر بمستجدات العصر.