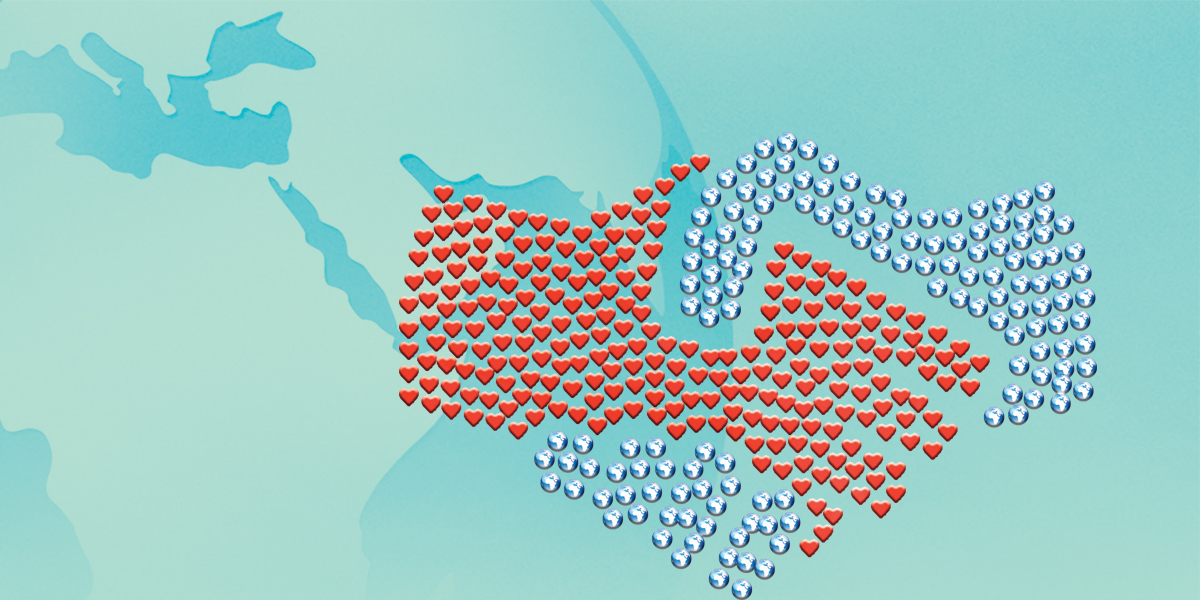ينبغي بادئ ذي بدء أن نؤكد أننا لسنا هنا في مقام محاكمة أو سياق مرافعة قانونية ولا حتى حقوقية حول ما يمسى بـ”الإسلامفوبيا”، لأننا إطفائيون يبحثون عن وسائل السلام والعافية للمجتمعات المسلمة والإنسانية العالمية. فذكر أسباب الظاهرة، لا يعني أننا نحاكم أناسًا آخرين قانونيًّا وأخلاقيًّا، إنما نبحث عن المقاربة الإيجابية التي تعيد الثقة بين المسلمين وغيرهم، والتي تجلي الصورة الحقيقية والصحيحة للإسلام.
ومع ذلك فإننا لا ندعي الوصاية على مواطني الدول الأخرى فيما يلجأون إليه من الوسائل القانوينة المتاحة لهم، للتصدي لخطاب العنف والكراهية ولنيل حقوقهم، فلكل سياق خصوصيته، ولكل مجتمع تنزيلاته الملائمة لأطر نظامه العام.
إن بحثنا ليس بحثا تقليديًّا، وإنما هو تشخيص لتلمس العلاج لهذه الظاهرة من خلال رصد تمظهراتها وسبر عواملها. فما هي هذه التمظهرات؟ وما هي هذه العوامل والأسباب؟
التمظهرات
التمظهرات لا تخطئها العين، ولا يحتاج إبرازها إلى كبير عناء، فهي معروفة ليس فقط من خلال ما يكشفه الإعلام، بل بحسب الباحث أن يجدها بارزة وجلية على أعلى مستويات التصريحات الرسمية العالمية.
فتمظهرات الظاهرة تتمثَّل في نمو خطابات الكراهية، والتمييز التي بدأت تغزو المشهد العمومي في المجتمعات الغربية من أطرافه، من خلال تنامي حركات كانت إلى وقت قريب هامشية، كأحزاب اليمين المتطرف والأحزاب النازية الجديدة، والتي تبني خطابها الإيديولوجي على فرض التناقض بينها وبين الغير. مع الإشارة إلى أن الكراهية لم تعد خصيصة غريبة، بل إن مناطق في العالم الشرقي أصيبت بلوثة الكراهية للإسلام والعنصرية ضد المسلمين من طرف بعض البوذيين وغيرهم.
لا شك أن هذه الأفكار قديمة بالجنس في الخطاب التقليدي للحركات الوطنية أو الشعوبية، ولكنها جديدة بالنوع في تشكلاتها الراهنة، حيث إن عنصر الجدة ومظهر الأزمة، هو تمكُّن الخطابات الإقصائية ذات النبرة العالية والتعابير الساخطة، من جذب قطاعات واسعة من الجمهور في دول كبرى لها إمكاناتها ومكانتها في العالم؛ فأصبحت هذه الخطابات تسهم في صناعة السياسات الكبرى في هذه الدول، فيما يتعلق بالهجرة وبتحديد الموقف من الأقليات المسلمة، بل وحتى في توجيه السياسة الخارجية أحيانًا.
إن من شأن الظواهر البشرية، أنها ترجع إلى شبكة عوامل متعددة متداخلة ومتضامنة، وهذه العوامل منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي، ومنها الحقيقي، ومنها الوهمي.
على أن هذا المشهد المتفاقم، لا يمكن أن ينسينا المواقف الحكيمة لحكومات غربية ولأحزاب لها وزنها وثقلها، ولغالبية هيئات المجتمع المدني التي تصدَّت لخطاب العنف والكراهية ضد المسلمين بالمبادرات القانونية وحملات التوعية والتضامن.
ما هي الأسباب والعوامل؟
إن من شأن الظواهر البشرية، أنها ترجع إلى شبكة عوامل متعددة متداخلة ومتضامنة، وهذه العوامل منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي، ومنها الحقيقي، ومنها الوهمي. وهذا التعدد هو ما يجعل البحث في الظاهرة متشعبًا، ويلزم الباحث حين يعالج الظاهرة أن يسبُر شبكة الأسباب، ويفحص قوة تأثيرها، ليخلص إلى انتقاء العامل المهيمن الذي ينبغي أن يُخص بمعظم المعالجة.
وقد أحصى الدارسون عدة عوامل، لكل واحد منها نصيب في تشكيل بناء الظاهرة وتكوين الإشكالية المؤسسة لمفهوم الإسلاموفومبيا.
فمن الباحثين من أناط المشكل بأبعاده النفسية التي يوحي بها استعمال كلمة “رهاب” (Phobia) بما تحمله من دلالات وجدانية. ومنهم من أبرز العوامل الاقتصادية مشدِّدًا على سياق الكساد الذي تمر به الاقتصادات العالمية، ودور المنافسة الأجنبية في سوق العمل في تأزيم وضع البطالة وتدني مستويات الأجور. ويفضّل آخرون الحفر والكشف عن الجذور التاريخية للظاهرة، من خلال إبراز دور الذاكرة في صناعة التصورات النمطية السلبية، التي ما تزال موجودة في الذهنيات والوعي العمومي، وتؤطر البنية الاستباقية للبحث لدى بعض المستشرقين والباحثين.
باعتبار هذا الفكر من رواسب مرحلة تاريخية خلت، حيث نشأ في سياقات تاريخية تتعلق بالحروب الصليبية وحروب استعادة شبه الجزيرة الإيبرية، أو في سياق بسط أوروبا نفوذها الاستعماري على العوالم الأخرى وتهيؤها لاحتلال شمال أفريقيا.. ولنذكر خطاب “أرنست رينان” الذي ألقاه في “كوليج دي فرانس” في 23 فبراير 1862، حيث قال: “في هذا الوقت المناسب، إن الشرط الأساسي لتمكين الحضارة الأوروبية من الإنشاء، هو تدمير كل ما له علاقة بالسامية الحقة بتدمير سلطة الإسلام الثيوقراطية؛ لأن الإسلام لا يستطيع أن يعتبر إلا كدين رسمي، وعندما يختزل إلى وضع دين فردي فإنه سينقرض. هذه الحرب الدائمة التي لن تتوقف إلا عندما يموت آخر أولاد إسماعيل بؤسًا، أو يرغمه الإرهاب على أن ينتبذ في الصحراء مكانًا قصيًّا.. إن الإسلام هو التعصب، إن الإسلام هو احتقار العلم، هو القضاء على المجتمع المدني، إنه سذاجة الفكر السامي المرعبة، إنه يضيِّق الفكر الإنساني ويغلقه دون كل فكرة دقيقة، ودون كل عاطفة لطيفة، ودون كل بحث عقلاني”.
إنه تصريح لا يحتاج إلى تفسير، وإن كل تعقيب من شأنه إضعاف النص كما يقول المستشرق الفرنسي المنصف “فنسان مونتاي”.
ولكن الإنصاف يقتضي أن نؤكد أن هذا الخطاب كان يمثل فقط أفكار بعض النخبة في تلك الحقبة ولا يمكن أن نعممه. فالكثير من المستشرقين والباحثين المنصفين عارضوا هذا التناقض بين الإسلام والغرب، ومن أكثرهم إنصافًا المستشرق “توماس أرنولد” في كتابه “دعوة الإسلام”؛ فكما أن الإرهاب لا يمثل رأي المسلمين أجمعين، فكذلك خطاب الكراهية لا يمثل رأي الغرب أجمعه.
بدون أن ننفي العوامل الأخرى، نقول إن العامل المسيطر والسبب المهيمن هو العلاقة المزعومة بين الإسلام والإرهاب، وبما أن البعد التاريخي الذي يختزل الذاكرة التاريخية في البعد الصدامي، ويحاول البعض أن يؤسس عليه حتمية الصدام الحضاري، قد أصبح -رغم فعاليته- يتوارى وراء العامل المسيطر وهو مسألة الإرهاب، حيث انضاف خلال العقود الأخيرة إلى السخيمة التاريخية ركام حوادث تحولت إلى أحداث مدوية، افتات فيها أفراد على الغالبية العظمى من المسلمين، فصدَّق كهانُ صدام الحضارة ظنهم، وتحولت الكهانة إلى كارثة.
اعترف الإسلام للآخرين بحقهم في ممارسة دينهم، فسدّ الباب أمام الحروب الدينية التي كاد التاريخ البشري أن يكون مجرد سجل لها.
ومن المفارقات، أن المسلمين في الإرهاب ضحايا من جهتين، فإن أكثر ضحايا الإرهاب -من جهة- هم المسلمون أنفسُهم، ومن جهة أخرى يظل المسلمون هم المتهمين الدائمين في جميع قضايا الإرهاب. تلك التهمة الناشئة عن جهل بالإسلام وتحريف للمفاهيم.
تحدث “فرنسيس فوكوياما” عن الأيديولوجيات المجنونة، وعن الديانات المجنونة، وخلص إلى أنه كما ماتت الأيديولوجيات المجنونة ستموت الأديان المجنونة كذلك. وإذا اتفقنا معه في إمكانية أن تكون هناك أيديولوجيات مجنونة، فإننا لا نسلم له بوجود ديانات مجنونة، لكن ينبغي أن نقر أن صناعة التدين -التي هي صناعة بشرية- أحالت الدين -هو في أصله طاقة تصنع السلام- إلى طاقة تصنع منها القنابل المميتة المبيدة للبشرية المهلكة للحرث والنسل، حين جعلت الدين وقودًا لنزاعات في أصلها دنيوية وسياسية، وجعلته يتفاعل كيميائيًّا مع تاريخ متخيل معسكر، وهذا ما يعني أن صناعة التدين إذا لم نحسن إتقانها، ولم ندرك أبعادها، فإنها يمكن أن تنفرط، وتتحول من رحمة إلى عذاب.
وقد عانت المجتمعات المسلمة من صناع هذا النوع من التدين من أهل الثقافة المأزومة الذين حكموا بالجزئي على الكلي، وتجاهلوا الواقع وعاشوا في القواقع، فقدموا فتاوى تتضمن فروعًا بلا قواعد، وجزئيات بل مقاصد، تجانب المصالح وتجلب المفاسد، فخلقوا فوضى فكرية سرعان ما استحالت دماء مسفوكة رغم عصمتها، وأعراضًا منتهكة رغم حرمتها، وعمدوا إلى مجموعة من المفاهيم -كالجهاد، وكالولاء والبراء، وكتقسيم الدار، وكالجزية وأهل الذمة- فانحرفوا بها عن سياقاتها اللغوية والشرعية والتاريخية، وخرجوا بها عن مقاصدها، ونسفوا كل شروط النظر الفقهي فيها، ولبَّسوا على المُغرَّر بهم مضامينها، وقفزوا على كل عناصر منهجية التعامل مع المفاهيم والنصوص الشرعية.
أما في المجتمعات ذات الأغلبية غير المسلمة، فقد طفت على السطح ظاهرة الخوف من الإسلام، أو على الأصح التخويف من الإسلام، اعتمادًا على أحداث سيئة، أو اعتمادًا على الواقع المستشري في الكثير من المجتمعات المسلمة تنمّط صورة الإسلام والمسلمين، خاصة بعد تمكن الجماعات المتطرفة والمأزومة، من استقطاب شباب ولدوا في الغرب ونشأوا فيه، وإقحامهم في أتون الحروب التدميرية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، وإقدامهم على ارتكاب أعمال إجرامية في البلدان التي ينتمون إليها، سواء كانوا أصليين في تلك البلاد، أو من الأجيال الثالثة والرابعة من المهاجرين الذين هاجروا إليها.
تنميط صورة الإسلام والمسلمين
وتنميط صورة الإسلام والمسلمين مرده في تصورنا إلى مجموعة من العناصر منها:
أ- التصورات الزائفة عن الإسلام النابعة من الجهل به، والقاعدة تقول “من جهل شيئًا عاداه”. فمن يعادي الإسلام، ينطلق من نفس المفاهيم التي تنطلق منها الفئة المتطرفة كالجهاد، والولاء والبراء.. وهذا التصور الزائف، مؤسس على مفاهيم اجتثت من سياقاتها اللغوية والشرعية والتاريخية، وبتنزيلها المنحرف أحدثت أذى وإضرارًا بالإسلام والمسلمين قبل غيرهم، وقبل الديانات الأخرى، وما تفجير المساجد والمعابد إلا دليل على ذلك. وهذا هو سبب الأسباب، وأس الأساس، الفكر المشوه، والثقافة المألوسة المأزومة. ولا يعدو الأمر أن يكون فهمًا خاطئًا وتصورًا منحرفًا لأفراد ومجموعات لا تمثل السواد الأعظم، ولا الرأي المعتمد.
بـ- فكرة صدام الحضارات وصراع الأديان، واعتبار قيم الحياة الاجتماعية الإسلامية غير قابلة للتواؤم والتعايش مع غير المسلمين: وينظّر لها مفكرون وخبراء إستراتيجيون، وفاعلون سياسيون، ومؤسسات إعلامية وفنانون.. وهي قاعدة “صدام الحضارات” التي أعلنها “هانتغتون”، والتي ألحّ فيها على أن الصدام قائم منذ قرون وأنه لن ينحسر. وبذلك اكتملت الصورة التي دشنها “فوكوياما” بنهاية التاريخ وأعلن فيها انتصار الحضارة الغربية.
إن الإيحاء بحتمية الصدام نتيجة تنوع الحضارات، إنما هو دليل على فشل كل حضارة في أن تدرك أهمية الاعتراف بحق التنوع، وهو الحق الذي سنبني عليه رؤيتنا في العلاج، باعتباره أساسًا للحوار ووسيلة للتعارف.
جـ- سلبية بعض المجموعات المسلمة في المجتمعات ذات الأغلبية غير المسلمة، وتخوفها من الاندماج في المجتمعات المحتضنة لها، إما كرد فعل على واقع التمييز والكراهية، وإما لاعتبارات ترجع إلى فهم ضبابي لمسألة الولاء للدين والوطن الأم دون إدراك، لأن الولاءات لم تعد دينية، بل صارت ولاءات مركبة ومعقدة تتحكم فيها عوامل متداخلة لا تنفصل عن بعضها، وينظر إليها باعتبارها دوائر ومراتب بإمكانها أن تتواصل وتتفاعل بدلاً من أن تتصادم وتتقاتل.
إن المرعب في هذا الواقع، سواء تعلق بالتطرف الديني والمذهبي العقائدي، أو تعلق بظاهرة الخوف من الإسلام أنه يواكب فترة زمنية تمتلك فيها البشرية أسلحة دمار شامل في إطار نظام عالمي قائم على توازن الرعب مع غياب الضمانات الكافية لعدم استعمالها، وخروج بعضها عن مراقبة الدول وسلطتها.
وقد كنا من عهد قريب نسعى إلى إطفاء حرائق جسد المجتمعات المسلمة، لكن يبدو أننا في حاجة إلى العمل الشاق على إطفاء حرائق جسد العالم وخفض حرارته التي يزيد منها التنازع على السيادة في بعض المناطق، أو على الثروات الطبيعية والمياه، والمطالب الانفصالية، والجريمة المنظمة، والمجاعات، والهجرات الجماعية غير المقننة، دون أن ننسى مخاطر التلوث البيئي على المستوى العالمي، والحديث عن الهويات الدينية والمذهبية والعرقية التي انتفخت، وعن ذاكرة السوء التاريخية التي استيقظت تجر موكبًا من المتعصبين والأيديولوجيات المتحاربة في الشرق والغرب، في عالم معولم تشيع فيه الأفكار والثقافات المختلفة، وتروج فيه المبادلات الاقتصادية والابتكارات التكنولوجية، ومن المفارقات أن وسائل التواصل والمواصلات زادت الهوّة اتساعًا بين البشر بدلاً من أن تقرب العقول والأفكار. وكل ذلك يقدم أسئلة ويستدعي بحثًا عن الأجوبة.
إننا نؤمن أن الاختلاف من نتائجه التعددية الدينية، ونؤمن أن التعددية الدينية في كل الأوطان اليوم صارت واقعًا عالميًّا، والقبول بهذه التعددية من خلال تنزيل مقصد التعارف وتفعيل المشترك، هو أمر تشهد له نصوص الدين الإسلامي.
هل يجوز للأديان أن تكون طرفًا في هذه الصراعات، تحش نيرانها حينًا، وتكون أداة فيها حينًا، وتخوف من بعضها البعض، أم ينبغي أن تجعل من نفسها المخلص المنقذ للإنسان والأوطان، فتكون عامل بناء لا هدم، عامل وقاية لا عدوى؟ هل من الضروري أن يبرز كل عصر “إسلاموفوبيا” خاصة به؟ هل من الضروري أن تنطبق على الواقع مقولة هيجل: “إن كل ما نتعلمه من درس التاريخ، أنه لا أحد تعلم من هذا التاريخ”، أم إنه ينبغي أن نتعلم من هذا التاريخ حتى يستقر السلم العالمي؟ أليس من الواجب تفعيل مقولة “هانس كيونج”: لا سلام بين الأمم ما لم يكن هناك سلام بين الأديان؟
مواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام
تترتب رؤيتنا العلاجية على طبيعة المعالجة الآنفة، وعلى ما جلّيناه من هيمنة العامل المتعلق بالإشكال الحضاري والديني، والذي يستبطن في عمقه سؤال الاختلاف والعلاقة مع الآخر، فيكون العلاج من جنس المضادات الحيوية التي ترتكز على مقاربات، منها مبادئ العلاقة الإنسانية في الإسلام. ومن عناصر الرواية الصحيحة للإسلام أن نعلم:
- أن الإسلام يعتبر البشر جميعًا إخوة، فيسدّ الباب أمام الحروب الكثيرة التي عرفها التاريخ الإنساني بسبب الاختلاف العرقي. والإسلام يعترف للبشر بحقهم في الاختلاف: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)(هود:118).
- اعترف الإسلام للآخرين بحقهم في ممارسة دينهم، فسدّ الباب أمام الحروب الدينية التي كاد التاريخ البشري أن يكون مجرد سجل لها.
- اعتبر الإسلام الحوار والإقناع الوسيلة المثلى: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(النحل:125).
- اعتبر الإسلام أصل العلاقة مع الآخرين المسالمة التي تقدم على بساط البرّ والقسط والإقساط.
إننا نؤمن أن الاختلاف من نتائجه التعددية الدينية، ونؤمن أن التعددية الدينية في كل الأوطان اليوم صارت واقعًا عالميًّا، والقبول بهذه التعددية من خلال تنزيل مقصد التعارف وتفعيل المشترك، هو أمر تشهد له نصوص الدين الإسلامي. فإننا نزعم أنه لم يعرف التاريخ دينًا ولا أمة قبلت بالتعددية الدينية واحتوتها كالدين الإسلامي والأمة المنتسبة إليه، ولقد كانت “صحيفة المدينة” التي تأسس عليها إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، إطارًا ناظمًا لترسيخ ثقافة قبول الاختلاف والتعددية الدينية والعرقية في المجتمع الواحد. كتاب يصرح بالتعددية الاختيارية، ويبني العقد على أساسها متجاوزًا ما يمكن أن تسببه من عوائق، بتقديم مصالح التضامن والتعاون في شكل حقوق وواجبات.
وكان من أهم ملامح حقوق الإنسان في الصحيفة الاعتراف بالتعددية، وإقرار حرية العقيدة بإقرار أهل كل معتقد على ما يعتقدونه، وأسست لقاعدة المساواة في الحقوق والواجبات ضمن بنية المجتمع المدني، حين نصت على مكونات الأنساق البشرية والقبلية والمساواة بينها ضمن الإطار الذي تستقيم به سيرورة المجتمع؛ بحيث كل جزء منها مساو للأجزاء الأخرى ومكافئ لها في ما يقبل التكافؤ، لا مكان فيها لمنطق التابع والمتبوع.. وبينت واجبات كل جزء تجاه مكوناته أولاً، وثانيًا تجاه باقي المكونات المشكلة لعموم المجتمع ضمن نسق العدل والمصلحة سلمًا وحربًا، ثم ثالثًا تجاه المكونات المحيطة به، استيعابًا من الصحيفة للتعدد الديني والعرقي والقبلي ضمن سياقين مرتبطين هما: سياق العدل كأدنى حد مطلوب، وسياق البر الذي هو أعلى المراتب المطلوبة في التعامل مع الإنسان، والذي يقتضي مع مقام العدل ألا يكون هناك حديث عن أقلية وسط وطن، وإنما الحديث عن أمة واحدة.
(*) أحد علماء الأمة المعاصرين، ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومؤسسة الموطأ في “أبو ظبي”. تم اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 50 شخصية إسلامية تأثيرًا في العالم للأعوام 2009-2016م / موريتانيا.
الهوامش
(1) هذا المقال جزء من الكلمة التأطيرية لمنتدى تعزيز السلم 2017 المعنونة بـ”السلم العالمي والخوف من الإسلام”.