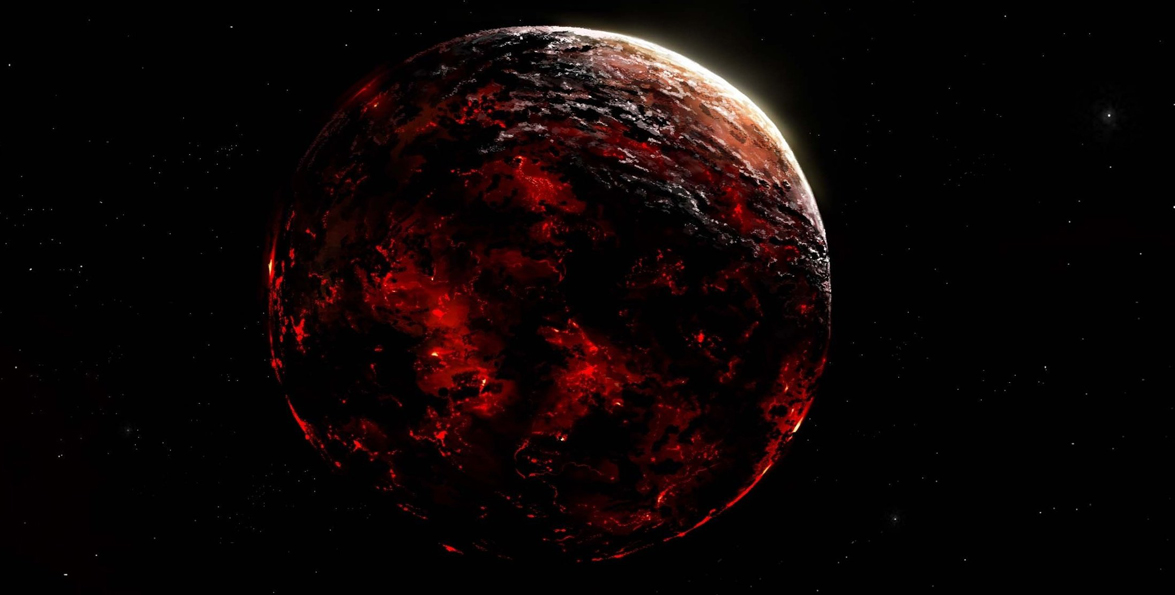قال الله تقدّست أسماؤه: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ* لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ)(المائدة27-28).
إن التعصب والأثرة، والشح وضيق الأفق، والتمركز على الذات، والحرص على تبرئتها، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والمسارعة إلى اتهام الآخرين، سبب لكثير من حالات التوتر، والمشاحنة والصراع.
وقال جلّ شأنه كذلك: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)(المائدة:64).
تشير هذه الآيات إلى المشكلة المزمنة التي يتخبّط في أتونها البشر منذ القدم وحتى اليوم؛ ألا وهي مشكلة الفساد في الأرض. والقرآن العظيم يقارب هذه القضية من ثلاث زوايا:
الأولى؛ حين استفهمت الملائكة عن المغزى من خلق الإنسان بقولها: (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ)(البقرة:30) فرد الله عليهم: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(البقرة:30)
وهذا البيان الإلهي يرسم الأفق البعيد والمستقبل الباسم الذي سيتحرك باتجاهه الإنسان؛ فإنه وإن بدأت مسيرته بالفساد والقتل وسفك الدماء، فإن منحى تطوره، ومآل تجربته إلى الدلالة الإيمائية الواسعة لقوله تعالى: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(البقرة:30)
الثانية؛ يتحدث فيها القرآن عن آدم وزوجه حين نهاهما الباري سبحانه بقوله: (وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ)(الأعراف:19)
لكنهما ركبا النهي، وخالفا الأمر، فأكلا منها كما قال جل شأنه: (وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ)(الأعراف:22)
فكان جوابهما: “ربنا ظلمنا أنفسنا”، فاعترفا بخطئهما، وتحملا مسؤولية فعلهما، وعزما على تقويم الوضع الخاطئ وتصحيحه، وهذا سبيل الإنسان دائمًا لتحسين سلوكه، وتطوير مدنيته، والتقدم في التاريخ؛ في مقابل سبيل إبليس الذي يصرّ على معصيته، وتبرئة نفسه مسوغًا لها تارة بحجة عنصرية “أنا خير منه”، وتارة بحجة فلسفية “فبما أغويتني”
والمغزى من هذا الحديث؛ أن التعصب والأثرة، والشح وضيق الأفق، والتمركز على الذات، والحرص على تبرئتها، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والمسارعة إلى اتهام الآخرين، سبب لكثير من حالات التوتر، والمشاحنة والصراع.
الثالثة؛ قصّة ابني آدم؛ فأحدهما لما فشل في عمله وتعبّده، ولم يتقبل منه؛ بادر إلى مواجهة صاحبه بالقول: “لأقتلنك” محملاً إياه المسؤولية فيما مني به من فشل، دون أن يتجشم عناء البحث عن الأسباب الموضوعية، لهذا التصرف وعواقبه، ثم فكّر وقدّر أن تصفية أخيه، ومحوه من الوجود هو الحل؛ لكن الإنسان الآخر الذي ذاق طعم الإيمان، وأدرك جوهره الإنساني -المتمثل في الخروج من حالة الغريزة إلى حالة العقل- لم يقابل السيئة بمثلها؛ ولم يدرأ التهديد بمثله؛ بل قال: (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ)(المائدة:28).
وهذه إشادة عظيمة، وتزكية فذة لموقف الرجل وصنيعه المنبئ عن وعي عميق، وإصرار كبير على ترك قتال أخيه، ورفض اللجوء إلى العنف بأي حال من الأحوال، فسن بذلك أسلوبًا جديدًا وعهدًا جديدًا في التعامل مع الخصم، وشكل صنيعه هذا نقلة نوعية للوعي الإنساني؛ أسفر عن نبذ العنف، ودرء حل المشكلات والنزاعات بتصفية المخالف ومحوه من الوجود، والبحث عن صيغة توافقية، وأرضية مشتركة للتعايش والتفاهم وتدبير الاختلاف.
والمغزى من هذه المواقف التنويه بشأن الإنسان، ومستقبله، وقدرته على تجاوز حالة الغريزة، والعنف والعنف المضاد، والاستفزاز السلبي، وسفك الدماء، ولكن بشرط أن يؤوب إلى رشده، وألا يُغلَب على عقله، وأن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها عروة “إني أخاف الله رب العالمين”. هذه واحدة؛ والثانية: أن يجتهد في تطوير خبراته المجتمعية، ومؤسساته المدنية القائمة على ثقافة الشورى والحوار والتوافق، وإدارة الاختلاف والنزاعات الطارئة والمصالح المتعارضة بصيغة جماعية تفاوضية قائمة على الاحترام المتبادل، وأسس العيش المشترك، والبحث عن السّلم الدائم.
لا شك أن أعبد الناس، وأقرب الناس إلى الله تعالى العاملون على إسكات طبول الحرب، وإخماد نيرانها، واتقاء أوزارها.
إن وجودنا في هذا العالم ليس عبثًا أو باطلاً؛ وإن سعادة الإنسان تنبع من معانقته لقضية عادلة، وإن أقدس تلك القضايا على الإطلاق أن يتوقف العنف والقتل، والفساد في الأرض، وأن يصطلح الإنسان مع أخيه الإنسان، وأن يبني معًا مجتمع المعرفة والعدل والسلام والتعارف على نحو ما يشير إليه قوله جل وعلا: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(البقرة:30) وقوله تعالى:(كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ)(المائدة:64).
فلا شك أن أعبد الناس، وأقرب الناس إلى الله تعالى العاملون على إسكات طبول الحرب، وإخماد نيرانها، واتقاء أوزارها؛ الذين يواسون إخوانهم في الإنسانية بمختلف أنواع الإسعاف والتضامن والمواساة، ويبذلون السلام للعالم، ويصنعون المجتمع الإنساني العالمي الذي يتساوى فيه أبناؤه وشركاؤه أمام القانون؛ لأن قيمة القيم، وخلاصة الإيمان كما قال عمار بن ياسر: “الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار”.