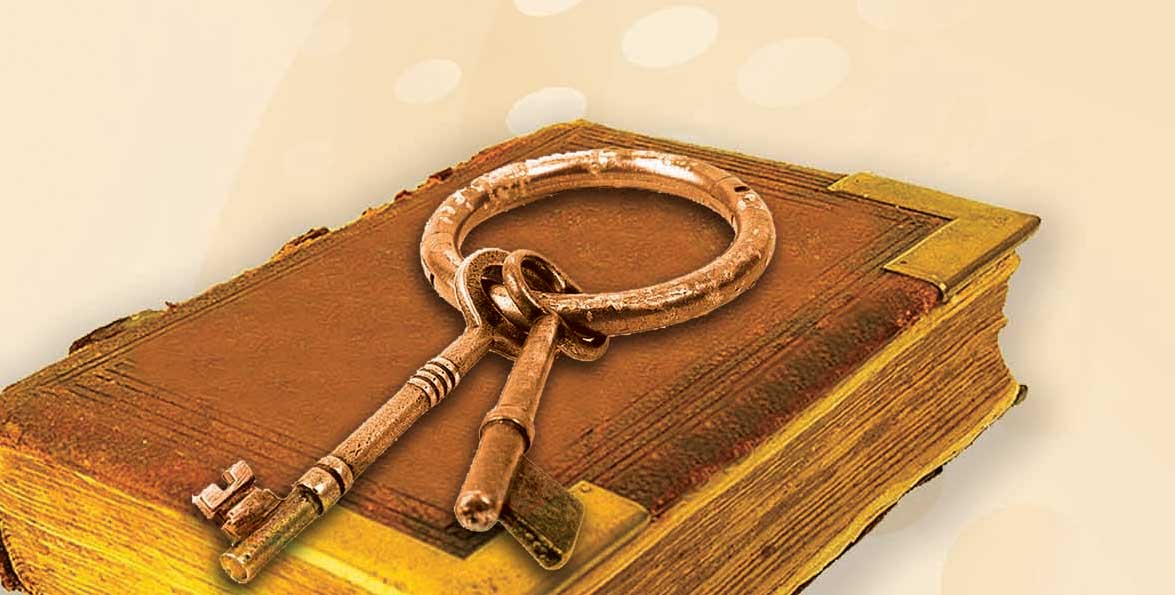من بين دفتي القرآن الكريم ومن سوره وآياته، ولدت الأمة الإسلامية وكل مقوماتها؛ من العقيدة إلى الشريعة إلى منظومة القيم والأخلاق.
ولأن القرآن الكريم منهاج شامل وكامل للدنيا والآخرة، للدين والدولة، للفرد والطبقة والأمة، للذات والآخر: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾(الأنعام:162-163). كان هذا القرآن الكريم، المنهاج الذي يكوّن العقل الموسوعي الذي لا يسجن طاقاته في التخصص والضيق والجزئي والمحدود.. يكوّن العقل الذي ينظر كيف بدأ الخلق، وكيف كانت المسيرة الإنسانية للأمم والشعوب والحضارات والنبوات والرسالات عبر التاريخ، ليعتبر بالسنن الإلهية التي حكمت الرحلة البشرية عبر هذه القرون.
ثم هو العقل الذي لا يعيش في الماضي مهاجراً إلى قرونه وتجاربه حبيسا فيها، وإنما هو العقل الذي يستلهم هذا الماضي ومواريثه ليفقه الواقع الحي والمتجدد الذي يعيش فيه، ومن ثم يمد بصره وبصيرته إلى المستقبل القريب والبعيد. ليس -فقط- المستقبل في عالم الشهادة بهذه الحياة، وإنما فيما وراء وما بعد هذه الحياة، أي إنه العقل الجامع -في موسوعيته- للبدء والمسيرة والمصير…
ولهذه الخصيصة الموسوعية للمنهاج القرآني، كانت آيات الوحي الإلهي التي نزل بها الروح الأمين -جبريل عليه السلام- على قلب الصادق الأمين -محمد بن عبد الله- عليه الصلاة والسلام، بمثابة “النواة” أو “الحجر” الذي أُلقي به في “البحيرة” لتنداح من حوله الدوائر المتعددة والشاملة لكل مناحي الحياة ومقوماتها. لقد انداحت من حول هذه “النواة” كل مقومات الدين والدولة والثقافة والمدنية والحضارة… وكل دوائر النور التي أضاءت حياة الإنسان الذي آمن بهذا القرآن الكريم.
كما أحيا هذا الإنسان الأرض الموات، فازدانت حياته “بالمدنية” التي هي عمران الواقع المادي، كذلك تهذبت ملكاته الروحية “بالثقافة” التي هي عمران النفس الإنسانية. ومن “الثقافة” و”المدنية” ومن تراكُمِ معارفِهما بمرور التاريخ، تكونت الحضارة الإسلامية التي هي إبداع مدني أثمره هذا الوحي وهذا الدين.
ظاهرة العلماء الموسوعيين
وبسبب من هذا المنهاج الموسوعي الذي يثمره الفقه والتدبر لهذا القرآن الكريم، تميزت الحياة العلمية والإبداع الفكري في الحضارة الإسلامية “بظاهرة العلماء الموسوعيين” الذين جمعوا -في إبداعاتهم- بين “عمق التخصص” وبين “شمولية الموسوعية”… فلم تقع عقولهم فريسة “لسجن التخصص” كما أنها لم تصب بالسطحية التي تفهم خطأ من “الموسوعية”.
وإذا شئنا أن نضرب بعض الأمثلة على الإبداعات الموسوعية التي أثمرتها عقول علماء هذه الأمة، الذين مثّل الواحد منهم موسوعة شاملة لمختلف العلوم والفنون، والذين برئت عقولهم وإبداعاتهم من الفصام النكد بين “عمق التخصص” وبين “الموسوعية”.. فتميزت موسوعيتهم بالشمول لميادين الإبداع في علوم المادة وعلوم الروح، في علوم الدين وعلوم الدنيا، في عالم الشهادة وفي معارف الغيب، في المنقول والمعقول، في الفلسفة العقلية ومنظومة القيم والأخلاق.
إذا أردنا أن نضرب بعض الأمثال على هذه القسمة الموسوعية في تراثنا الفكري والعلمي، فسنجد على سبيل المثال:
• حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (1058-1111م) الذي مثل “ظاهرة فكرية” لعلوم عصره؛ من الفقه إلى الأصول إلى الفلسفة إلى التصوف وعلم القلوب والسلوك.
• وأبو الوليد بن رشد (1126-1198م) الذي كان الناس يفزعون إلى فتواه في الفقه كما يفزعون إلى فتواه في الطب، والشارح الأكبر لأرسطو والمتفرد بالكتابة في فلسفة اختلاف الفقهاء وفي علم الكلام، والجامع بين علوم المعقول والمنقول، والمقاصد والوسائل… حتى لقد كان فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء.
• ابن سينا (980-1037م) الذي كان “الشيخ الرئيس” في الشرعي والمدني، في الإلهيات والطبيعيات، في التصوف وفي النبات والحيوان.
• والبغدادي -أبو منصور عبد القاهر- (1037م) الذي جمع بين أصول الدين والهندسة والحساب…
• والخيام -أبو الفتوح، عمر بن إبراهيم- (1121م) الذي كان موسوعة في اللغة والشعر والفلسفة والتصوف والفقه والتاريخ والفلك والهندسة والرياضيات…
• والفخر الرازي (1150-1210م) الذي جمع بين علوم الدين والدنيا؛ من التفسير إلى الفلسفة إلى الكلام إلى الأصول… حتى قال مؤرخوه: “إنه كان أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل”… وغيرهم آلاف من العلماء والموسوعيين.
فن التأليف الموسوعي
ولم تقف “القسمة الموسوعية” في الحضارة الإسلامية عند إبداع “العقل والموسوعي”، وإنما أثمرت أيضاً “فن التأليف الموسوعي” الذي اشتهر به العديد من العلماء الذين توفروا على تأليف وتصنيف الموسوعات التي تجمع شتات العلوم والمعارف والفنون والآداب، لتزكي وتنمي “القسمة الموسوعية” لدى طلاب العلم والباحثين والقراء والمتأدبين.
فعرفت حضارتنا موسوعات “الطبقات” التي أرخت لحياة العلماء الأعلام وإبداعاتهم في مختلف مناحي العلوم والفنون، وموسوعات “الخطط” التي أرخت المواقع والمكان والمؤسسات والثروات والتجارات والخانات والرحلات وأنماط المعاش والعادات، وموسوعات “كشافات المصطلحات” في مختلف ميادين المعارف والعلوم والفنون، وموسوعات “اللغة” وعلومها، والموسوعات التي توفرت على “علوم القرآن الكريم” و”علوم السنة النبوية الشريفة”…
فمن “طبقات” ابن سعد (784-845م) إلى “الفهرست” لابن النديم (1000م) إلى “العين” للخليل بن أحمد (718-786م) إلى “إحياء علوم الدين” للغزالي (1058-1111م) إلى “العقد الفريد” لابن عبد ربه (860-940م) إلى “الأغاني” لأبي فرج الأصبهاني (897-967م) إلى “التعريفات” للجرجاني (1340-1413م) إلى “لسان العرب” لابن منظور (1232-1311م) إلى “نهاية الأرب في فنون الأدب” للنويري (1278-1333م) إلى “معجم البلدان” و”معجم الأدباء” لياقوت الحموي (1180-1229م) إلى “أسد الغابة في معرفة الصحابة” لابن الأثير (1160-1223م) إلى “الاستيعاب في معرفة الأصحاب” لابن عبد البر (978-1071م)… آلاف وآلاف الموسوعات التي أصبحت “فناً” من فنون التأليف في حضارة الإسلام، والتي نهضت برسالة “خَلْق العقلية الموسوعية” لدى طلاب العلم والقراء، وذلك حتى لا يصبح العقل سجيناً للتخصص المحدود.
فبعد عصر التدوين مر العلم والفكر -في حضارتنا- بطور “التخصص” الذي انقسم فيه العلم الواحد إلى عدة علوم. ولقد كانت هذه الموسوعات هي السبيل إلى جمع أطراف المعارف في هذه العلوم، لمساعدة العقل المسلم على أن يظل متكاملاً، وأن يتمكن طالب العلم الإسلامي من تكوين “العين للأمة” التي تنقذ العقل من النظرة الأحادية التي تقيم فصاماً نكداً بين صاحبها وبين مختلف عوالم العلوم والمعارف والفنون والآداب…
وبعد نكبة الغزوة المغولية (1258م) التي دمرت الكثير من ذخائر المكتبات الإسلامية في الحواضر التي اجتاحها المغول، والتي أحدثت “شرخا” في “الذاكرة الإسلامية”، قامت الموسوعات -في العصر الأيوبي والمملوكي- بجمع شتات الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية والفنون والآداب، فحفظت للذاكرة الإسلامية التواصل مع المنابع والأصول والجذور.
تلك كانت رسالة الموسوعات في الحضارة الإسلامية: الحفاظ على العقل الموسوعي الذي يسترشد بالقسمة الموسوعية التي أرسى قواعدها القرآن الكريم في العقل الفردي والجمعي والحضاري لأمة الإسلام.